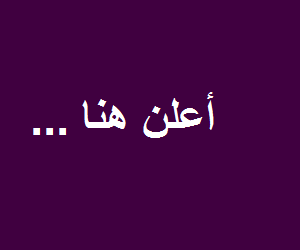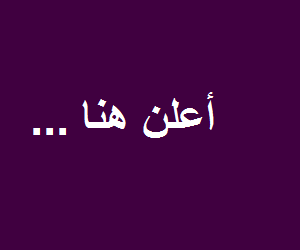بهنس.. هزائم الجيل الثالث (2)
بهنس.. هزائم الجيل الثالث (2) عماد البليك مثلت فكرة الهزيمة عنوانًا للجيل الثالث الذي عاش طفولته في سنوات جعفر النميري (1969 -1985)، ومن ثم صباه على انتفاضة شعبية (أبريل 1985)

بهنس.. هزائم الجيل الثالث (2)
عماد البليك
مثلت فكرة الهزيمة عنوانًا للجيل الثالث الذي عاش طفولته في سنوات جعفر النميري (1969 -1985)، ومن ثم صباه على انتفاضة شعبية (أبريل 1985) سرعان ما أجهضت، ليدخل نضوجه المعرفي والثقافي في عهد "الإنقاذ" مع انقلاب 30 يونيو 1989، وهنا يمكن الإشارة إلى جملة من التحولات العالمية في تلك الفترة من نهاية الحرب الباردة وانهيار سور برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي، وغيرها من العوامل الخارجية التي لا يمكن عزلها عن المتغير الداخلي من محاولة السلطة المحلية تسوير الحياة الاجتماعية والثقافية في البلاد باسم "التثوير"، وما تم من حركة كبيرة باسم الدين برزت أوضح مظاهرها في حرب الجنوب "الجهادية" التي مهدت للانفصال لاحقا، وعمليات التعريب ومحاول أسلمة الحياة وفق القالب "الأخواني".

هذه المعطيات ضرورة لكي نفهم أن الجيل الذي عاش هذه الصورة وهو جيل بهنس، كان أسير هذه التمزقات فإما أن يتجه إلى أن يكون "جهاديًا" في الجنوب ويتكلم عن العوالم الغيبية وما وراء المحسوس ويروج لفكرة الدولة الدينية التي أصبحت فيما بعد هلامًا ماديًا، أو أن ينزوي إلى فضاءات الانعتاق الشخصي من محاولة إنقاذ الذات بأي شكل كان، عبر الاغتراب النفسي الداخلي أو الهجرة الخارجية، وكلاهما أشكال من الغربة الإنسانية التي يعاني منها الإنسان المثقف والفنان والشفاف بشكل أوضح كما في نموذج بهنس، الذي سوف يجد في الهجرة فيما بعد ملاذه، بعد أن وجد أن فكرة الوطن ليست بذات السعة.

فنون ادائية تجسيدية لبهنس
ويبدو أن هذه الحل "قدريًا"، فعلى مدار أجيال متعاقبة مثلت هذه المسألة صورة لتحقق الذات، كانت جلية في نموذج مصطفى سعيد (موسم الهجرة إلى الشمال) لتنتهي بفناء البطل سواء كان قد غرق في النهر أو انتحر أو غاب ليبحث عن وجوده في مكان أو فضاء آخر، حيث يبقى المشكل الأساسي قائمًا، تلك الذات الباحثة عن حقيقتها سواء كانت فنانة أو متصوفة أو مثقفة الخ..

بهنس في سنوات البحث عن معني مختلف للعالم
قديما رأينا أشواق التيجاني يوسف بشير بالتفكير في الهجرة إلى مصر التي كان يرى فيها الحداثة والانفتاح ولم يكتمل الحلم، التي كان قد اسماها في واحدة من قصائده "مستودع الثقافة" وقال عنها:
نضر الله وجهها فهي ما
تزداد إلا بعدًا علي وعسرًا

وقد كان ثمة مراكز ثقافية معينة تشكل مفتاح المعرفة والتبصر الثقافي للسودانيين هي لندن والقاهرة، ومن ثم يمكن إضافة باريس أو عموم فرنسا لاحقًا في تجربة بهنس، وهنا أشير إلى رواية "صباح الخير أيها الوجه اللامرئي الجميل" للاستاذ عيسى الحلو، التي جاءت متزامنة مع الانتقال في الألفية، وأخذت باريس كمقابل موضوعي للندن، وهنا ثمة ملاحظة لابد من التركيز عليها، وهي أن هذه المقابلة كانت مهمة لتفسر التحول، لتصبح باريس هي معادل احتواء الفنانين والتشكليين والمثقفين في حين أن لندن رغم وجود هذه العناصر فيها إلا أنها ستبدو عاصمة الرأسمال وعلماء الاقتصاد والحوكمة أكثر من ارتباطها الكبير بالجدل الثقافي والفني. برغم أنها استضافت سابقا شخصيات كالصلحي والطيب صالح، لكن يمكن ربط ذلك بطبيعة الثقافة الفرنسية ذات المنحى المعرفي والفني والجمالي.

في الخرطوم يوجد العديد من المراكز الثقافية التي لعبت ولا يزال بعضها يؤدي هذا الدور، من نشر الثقافة ومدّ الجسور مع المثقفين والراغبين في المعرفة، حتى لو أن ذلك يتم وفق ما يرغب الذهن الآخر في تشكيله وزرعه من ثقافته في المجتمع، يتجلى ذلك واضحًا في المركز الثقافي البريطاني والمركز الثقافي الفرنسي ومعهد جوته، وكان ثمة آخر أمريكي لم يستمر طويلًا، هذه ضرورية في فهم الأشواق التي كان ينسجها مثقفون وفنانون قبل أن يكون لهم الانتقال فعليًا إلى تلك البلدان، وقد شكلّت بيئة للاستجمام والاسترخاء النفسي والبحث عن الذات المفقودة وسط زخم "الإنقاذ" والفوضى الضاربة في الداخل الثقافي، والغريب أنها ظلت تمارس دورًا قد لا تكون السلطات تضع له كبير اعتبار لفترة طويلة سواء تم ذلك بوعي أو لا وعي. هذه الفضاءات شكلت اهتمامًا لبهنس وجيله من الشعراء والشباب الفنانين والباحثين عن فلسفة لحياتهم تكسبهم المعنى.
في تلك الفترة أيضا هناك مسألة مهمة ينبغي التنويه لها، وهي أن قضية العلاقة المتأزمة مع الدين لدى بعض الشباب من الجيل "الرابع" ما بعد الألفية، لم تكن قد كسبت ذلك الثوب المعقد من الوصول إلى حالات من الإلحاد الكبير، حيث لا زال العقل الثقافي يقوم على عملية ربط بين اليقين والشك؛ كأنه امتداد للعقل القديم ذاته في نموذج التيجاني يوسف بشير، غير أن ممارسات الواقع السياسي ومحاولة فرض سلطة "الأسلمة" القسرية كل ذلك كان له دور في تنشيط الذهن لإعادة التفكير في مجمل تصورات الدين وقضايا الإيمان ومكتسبات الإنسان في حياته من خلال وجود خلفية يستند عليها لكى يرى ذاته سواء من خلال بعد ملموس أو متخيل.
رحلة البحث هذه التي تتراوح بين مساحة اليقين والشك لم تكن مجرد فكرة ذهنية منغلقة، بل كانت لها انعكاسات في الممارسات الإبداعية لدى النماذج المثقفة في الجيل الثالث، الذي عاش هذه الحيرة وهو يرى المفارقة بين الواقع والطموحات، وهنا فقد اتجه إلى فك حصار الأفكار إلى تجسيدات برانية للمتخيل المنغلق، تمثلت في الشعر أو التشكيل وغيرها من الأطر المرئية أو كالفنون البصرية والأداء والتمثيل، وقد كانت شخصية بهنس مؤهلة لكل ذلك، بحيث أنه بتعبير بسيط، استطاع أن يجمع من كل بستان زهرة. كأنما كان مسلكه تجريبيًا حتى لو لم يكن ذلك بالشكل الإرادي، وكانت فضاءات الخرطوم في تلك الفترة من نهاية التسعينات تسمح بذلك الشيء ما يجد فيه الشباب المثقف متنفسًا، بخلاف صورة الخرطوم الأخرى التي كان يسوّق لها النظام وهو يستضيف مؤسسات ذات طابع "إسلاموي"، أو شخصيات كأسامة بن لادن، وغير ذلك من الصور.
كانت الخرطوم تسمح بتمرير بصيص الضوء من خلال المؤسسات التي ذكرت سابقًا ذات البنية الثقافية الغربية، وكان الباحثين عن "الاختلاف" في جوهره الفلسفي لا الشكلاني، يستفيدون من هذا المناخ بشكل عام، الذي سوف يُمكِّن في نهاية المطاف من الهجرة أو البقاء في المكان ولكن بوعي جديد ومختلف، حتى لو أن الفرد سوف يجابه قسوة الواقع الاقتصادي والسلطة الاجتماعية التقليدية وغيرها من القيود التي تكبل حرية العثور على الذات المتمناة.

يبقى أن كل هذه الأجواء وفي ظل ارتباطها بإرث لجيلين سابقين، لم يصنعا أرضية صلبة لاستمرارية التعايش وانتقال الخبرات والتجارب بين الأجيال؛ قد جعلت الذات المثقفة والفنانة أحادية في فكرة البحث ورغبة التحقق، وهو ما اصطح عليه بمشروع "الخلاص الفردي"، وهو للأسف قائم ويتجدد بصور عديدة في الأجيال المتواترة لتبدأ حلقة التجريب من مرة لأخرى، وتتكرر ثانية مع جديد جيل، ويستمر التأزم الذي انعكس في الهزيمة لدى جيل كامل.




 myasinplatformltdcom
myasinplatformltdcom