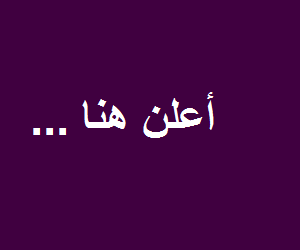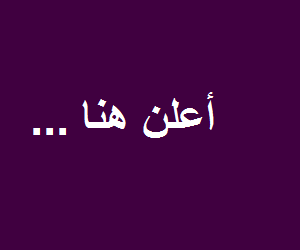ديمقراطية التأويل
ديمقراطية التأويل لمياء شمت أسهم عدد غير قليل من المباحث والدراسات العلمية في إعادة تعريف عملية القراءة، ورد الاعتبار إليها

ديمقراطية التأويل
لمياء شمت
أسهم عدد غير قليل من المباحث والدراسات العلمية في إعادة تعريف عملية القراءة، ورد الاعتبار إليها، من حالة كونها محض استقبال واستهلاك سالب، إلى حقيقة أنها نشاط تفاعلي معقد، بأبعاد تواصلية وتشاركية، تتصل باشتغالات ثقافاجتماعية ونفسية ومراقي تذوقية جمالية، يستخدم فيها القارئ نظام علاقات شفري مركب، يرتبط بمخزون ذاكرته، وجملة تجاربه الحياتية وخبراته الوجودية، وذخيرته المعرفية وحساسيته الجمالية. وهكذا فقد أفلح تسليط الضوء البحثي الفاحص على عملية القراءة في العروج بها من هامش الاستهلاك إلى مركزية الإنتاج. حيث لا يقتصر الدور الحيوي والمحوري للقراءة على أفق التواصل والتشارك، بل يمتد إلى كونها عملية موازية للنشاط الإبداعي، بل إنها هي ما يمنح النص حياته وهويته، "إذ لا وجود مستقل للنص خارج عملية القراءة". ولا يهدف ذلك بالضرورة إلى تنحية النص، بقدر ما يسعى إلى تحفيز الحوار المتكافئ بين تلك الأقطاب، وترفيع الإبداع من مقام الآحادية والقصدية وسلطة الصوت الواحد، إلى سعة التعدد والتساوق وشمولية الرؤية، ليتحول الأمر من سلطة قد تبدو استحواذية وقابضة، إلى علاقة تبادلية تكاملية، يتوجه فيها النص الإبداعي إلى قارئ فاعل، يقوم بمبادرات تأويلية نشطة وحاذقة، تحاور النص، وتستبصر شبكات علاقاته الداخلية، وتغوص لتظفر بذخائره وشفراته المستترة.
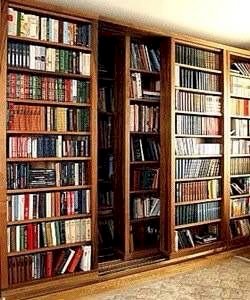
وقد أفضى إعلاء دور القارئ بدوره إلى سك عدد من الاصطلاحات والصفات، التي تتوسل رسم صورة بارزة لقارئ (كفء/ نموذجي/ مثالي)، حيث تلتقي كل تلك الخصائص عند قارئ مُحتمل يضمره النص كعصب تأويل استراتيجي. وهو ما يحُثنا للوقوف عند إشارة إيكو (لغابة السرد) كإحالة لماحة للتشابك الدغلي للنصوص، ولعوالمها المفتوحة غير المستنفدة. وكذلك هو الحال عند الإشارة لموسوعية القارئ، والتي تحيل بدورها إلى سعة واختلاف وتعدد العلاقات والممكنات التي ينشئها القارئ مع النص، حيث التعويل على قارئ منفتح، لماح، صبور، بصير، بل وعنيد بما يكفي للتعدين في طبقات النص، والسعي إلى ما وراء حدوده.
ورغم ما يوحي به الأمر من ازدهار لديمقراطية التلقي والتأويل، إلا أن إيكو يريدها ديمقراطية مشروطة بسقف وحدود. إذ لا بد أولاً من نص سخي مكتنز بالدلالة، ومتسم بالجدة والأصالة. ثم يأتي دور القارئ الذي يتوجب أن يصغي لصوت النص، ويتبع إشاراته، بقراءة تساوق منطق النص، وتتلاءم مع طبيعته وإمكاناته وروابطه، ونسيج عوالمه الداخلية. ووفقاً لذلك فلا بد أيضاً من استراتيجيات نصية تعمل على توجيه القارئ، لكبح شطح التأويل الجامح. وهكذا فإن ديمقراطية التلقي تكون معادلاً موضوعياً للحرية المسؤولة الملتزمة. وهو عين ما اختصره إيكو في مصطلح "التعاضد التأويلي"، حيث يتوجب أن تُحترم قواعد اللعبة المشتركة، لتتعدد القراءات بأنواع وطبقات واستجابات متنوعة، تؤكد على تعددية وتباين مستوى العلاقة بين القارئ والنص، وعلى الدور الحيوي لدينامية التأويل، ومقدرته على جس عصب النص، واستنطاق مسكوتاته وكشف مضمراته.

ومن بين زكائب ذلك التل المهيل للدراسات والمقاربات المتمركزة حول قطب القارئ، يكتب الناقد السعودي محمد العباس، في تأملاته حول مكابدات قصيدة النثر، عن الحاجة لقارئ نوعي بذائقة اختراقية منفتحة، ومثاقفة للحظة الإنسانية والإبداعية، ليقوم ذلك القارئ بفعل قراءة مجاوز لأرشيفية الذائقة التقليدية، ولإملاءاتها الحاجبة، وقدسيتها المتوهمة، وليعبر ذلك القارئ الارتيادي المُساجل فوق ركام هائل من المصنمات والروادع والإعاقات التذوقية، التي تقعد به عن استشراف أفق التلاقح الثقافي والتذوقي المتجدد، والمنفتح تجاه الحساسيات الجديدة. ورغم إرباك وطنين السلفيات وإكراهاتها، يمضي ذلك القارئ المفارق للمألوف، ليُعمل خبراته وشبكته التفاعلية المركبة، التي تنماز عندها الاستغفالات الحداثية المجانية، عن النصوص الإبداعية ذات الأصالة والجوهرانية، والاكتناز الجمالي والرؤيوي. ويستدل العباس، غير مرة، بحداثة أبي تمام، الذي ظل مُصراً على أن يفهم المتلقي ما يقال وليس العكس بأية حال. ولعل ذلك القارئ النوعي هو الأفق الإدراكي والمعرفي والتذوقي الذي يستسره وعي كل مبدع.




 myasinplatformltdcom
myasinplatformltdcom