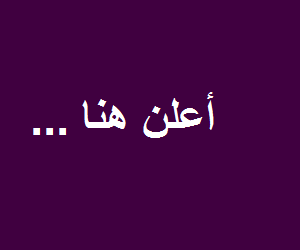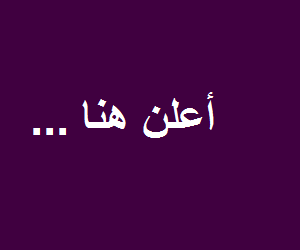حكائية عبد الحميد البرنس
حكائية عبد الحميد البرنس ثالوث الغربة والوحشة والحنين لمياء شمت متواليات سردية تنهض جذوعها وتتمدد عذوقها من بذور التجربة والمشاهدات اليومية التي يغترفها القاص من تدفق مجرى الحياة، ليصوغها بلغة أليفة صافية تتحالف مع أسلوب هادئ مقتصد متضام، يشي بأن المشروع السردي للقاص عبد الحميد البرنس آخذ في إتمام نضجه عبر اشتغالات حكائية متنوعة وتجريب مستمر، يكدح عبره القاص بعزم ليجوهر أسلوبه وصوته الخاص.

حكائية عبد الحميد البرنس
ثالوث الغربة والوحشة والحنين
لمياء شمت
متواليات سردية تنهض جذوعها وتتمدد عذوقها من بذور التجربة والمشاهدات اليومية التي يغترفها القاص من تدفق مجرى الحياة، ليصوغها بلغة أليفة صافية تتحالف مع أسلوب هادئ مقتصد متضام، يشي بأن المشروع السردي للقاص عبد الحميد البرنس آخذ في إتمام نضجه عبر اشتغالات حكائية متنوعة وتجريب مستمر، يكدح عبره القاص بعزم ليجوهر أسلوبه وصوته الخاص.

وهكذا فأن السرد قد يبدو في أحيان كثيرة وكأنه لا يحتاج لأي ذريعة لينطلق من أي زاوية قد يرتكنها السارد، سواء أكان ذلك شارع مترب، أو مسكن صغير خاوٍ، أو حتى عربة مترو مزدحمة. ليقودنا القاص كل مرة إلى فضاء أنساني مفتوح، تتلاحم فيه سحنات وألسن ومصائر، يجمعها أفق سردي وسيع، لا يشيح فيه المحكي للحظة عن المشترك الإنساني.
فتتوالى الحكايات التي كثيراً ما تُظهر الشغف الكبير بتوظيف التقنيات السينمائية، عبر مشاهد تصويرية قد تحتقب الراهن، أو تستدير لتسترجع لحظة مستعادة، أو لتعبر إلى القادم. مع الحرص على تثوير اللقطات بما تحويه من تقاطعات حركية ولغوية ودلالية تأثيرية، وكذلك التنويع في المنظور وزوايا الرؤية، مثل الإطلال على بؤرة المشهد من مسافات وزوايا متعددة، تطمح لكشف دواخل النص والحفاوة بتفاصيله وملامحه الخاصة. حتى أن بعض النصوص قد تبدو أحياناً مثل وثائق فلمية لذوات تعارك الحياة وهي تتأبط غربتها.
لتتشكل النصوص وفقاً لذلك كمقامات سردية مفتوحة، أو كمنطقة حرة مبذولة للتداخلات الأجناسية، التي تظهر في شكل تبادل طاقوي محتدم بين أجناس أدبية مختلفة، تتفاعل فيه عناصر الخاطرة والاسترجاع ويتقاطع فيه الصوت السيري والسردي والأنفاس الشعرية، مما يفسح مساحات أكبر للاشتباكات الفنية الجمالية المنتجة، التي تتولد من تلك التفاعلات الأجناسية.

ولنتأمل على سبيل المثال اعتمالات الذاكرة وتسرب قطرات الذاتي إلى مجرى الإبداعي في نص(شراء لعبة تدعى كيربي)، من مجموعة (ملف داخل كمبيوتر محمول). والذي يحكي فجيعة فقد صديق حميم، تقاذفته المغتربات وفلوات الشتات. حيث لا يحتاج القارئ المتابع لإنتاج القاص عبدالحميد البرنس، وخاصة كتاباته التفاعلية المتاحة عبر منابر التواصل، لا يحتاج لكثير عناء ليلمح طيف الراحل سامي سالم وهو يتدثر بشخصية صالح الطيب في ذلك النص. في حضرة إفراغ إبداعي كثيف، يختصر تفاصيل غرس صداقة أخضر سقاه الوجع حتى الذبول.. (كان جسده وهو ممدود على فراش موته يحكي ببراعة مذهلة عن كل تلك الملابسات والوقائع والأحداث التي يمكن أن ينطوي عليها التاريخ العريق للفقر والمعاناة). ولنقف قليلاً عند انتخاب أسم صالح الطيب بدلالته المكتنزة بالسماحة والسعة ونصاعة الطوية، حيث يظهر انعكاس الأسماء في مرآة الوجدان لتبدو المقابلة الدلالية بين سامي: صالح ، سالم: الطيب، برمزيتها المضمرة التي تجمع بين الراحلين الطيب صالح وسامي سالم في معارج باذخة يستبطنها ذهن القاص.
ولابد لذلك أن يقودنا بدوره إلى نقطة مركزية كان القاص قد أشار إليها في حوار أجراه معه الأستاذ أحمد ضحية في العام 2004.حيث أكد البرنس على أهمية توفر قدر من الإبهام وعدم المباشرة لخلق نص مفتوح يتيح كل التأويلات الممكنة. مع حرص القاص على التنبيه مراراً إلى خطورة المطابقة بين شخصيات المؤلف والراوي، أو بطل العمل الإبداعي، كأمر فادح قد عانى منه كُتاب في قامة الطيب صالح.وينوه القاص إلى أن ذلك يُشكل بدوره آلية قمع وقتل معنوي للمبدع، خاصة في كنف مجتمع أبوي صارم. وهي رؤية تتماس كثيراً مع مناخ(شراء لعبة تدعى كيربي)، حيث تنبلج عبر السرد تفاصيل اشتغالات القاص الحثيثة، لتوظيف أفق العلاقة بين السيري والسردي والذاتي والإبداعي والاسترجاع واعتمالات الذاكرة بتمهر مكين لرفد المحكي وتأثيث عوالمه، ليرتفع معمار السرد كما ينبغي له، كنظر متأمل سابر يقدم تأويله الخاص للعالم.
ولنقرأ في شق آخر ملاحظة الناقد المصري يسري عبدالله حول مجموعة (ملف داخل كمبيوتر محمول) ،عن ذلك الحضور البارز لتيمة الاغتراب، كمفهوم سيكولوجي ووجودي في نصوص القاص عبد الحميد البرنس، والتي (تبقى حاوية ظلالاً من غربة الروح التي تهيمن على المجموعة وتشكل مركز الثقل داخلها).حيث ينتبه الناقد إلى أن الغربة في نصوص البرنس ليست بأي حال (رومنطيقية ساذجة تحوي تلك النهنهات العاطفية القديمة، لكنه تشبث بملامح عالم قديم، ومحاولة استعادته عبر الذاكرة). وهو ما يعين على التأكيد بأن الاغتراب لا يحضر في نصوص البرنس داخل ذلك الاطار المنمط، كحالة من التهالك والتشكي من صهد هاجرة الغربة، ولكن الفكرة تظل تنسكب عبر النصوص كاجتياحات ذهنية وعاطفية لا تجدي مكافحتها، تمضي لتُشكّل خمائر أفكار وتأملات ورؤى.

وهو ما يعيدنا كَرة أخرى إلى تقاطعات اليومي والعابر والعادي عبر ذاكرة سردية لاقطة، تنتخب ما تشاء من لقطات حية من دفق الحياة الرازم، حيث تتفاعل الذات مع محيطها الوجودي في مصاهر التجربة، ثم تنبري إبداعياً لتسخير ممكنات اللغوي والتخيلي، للجهر بأسئلتها الوجودية الخاصة. ويبدو ذلك جلياً في تيمة الاغتراب التي يعلو بها القاص فوق البكائيات والانسحاق، ليحاورها وينفتح بها على الآخر، دون أن ينكص بها إلى درك الريبة والانكفاء والتشرنق وانعدام الفاعلية. فالقاص يمضي ليجعل من الغربة هوية رؤوم يتسع صدرها للغرباء في كل العالم، ليتضاموا ويستقووا ببعضهم على وحشة العالم، على نمط (فالعاشقون رفاق). بل أن الغربة إخاء يمكن أن يوحد الغرباء حتى في ملامحهم وإيماءاتهم: (كنا نسير مثل غريبين حقيقيين)، ( لها نظرة الغرباء الحزينة الساهمة)، (سألته بشيء من حيلة الغرباء ومكرهم)، (وضحكنا معاً كغريبين من بلاد بعيدة).
ليستل القاص من كل ذلك أجابته الخاصة على سؤال لماذا الكتابة متماهياً في ذلك مع كونديرا وبورخيس: أكتب لمجرد أن يخف مرور الزمن، أن معنى العالم على هذا النحو أثقل من أن يحتمل. وهو ربما ما يعيننا على محاولة القبض على ملامح المشروع الإبداعي لعبد الحميد البرنس، والتي تبدو أقرب ما تكون لسرد فينومينولوجي يعود بالأشياء إلى كنهها، في محاولة لإدراك العلاقة بين الذات والموضوع، بتسخير طاقات الرؤية والحدس والاستبصار، دون أقصاء للحس ومدركات الشعور. ونجد أن ذلك غالباً ما يظهر على شكل ارتدادات تأملية تتدبر الوجود بوعي متعمق، مع إعمال لنظر داخلي مستريب يتيح تفكيك المستقرات والتنميطات والقوالب والمسبقات، في محاولة مخلصة للتوفيق بين الذات والوجود دون إصدار أحكام أو تبني أفكار جاهزة.
وهو ما قد يفسر أنسنة القاص للمكان بشكل لا يتغيا إثبات كينونته الفيزيقية المادية، بقدر ما يكدح لاقتناص شرطه الإنساني، هويته البيئية ولحظته الحضارية الخاصة، بإدراك رحب، وبوعي باطني شفيف يعتق ذلك الحيز من ماديته وحياديته، ليسخره كفضاء مفتوح على الخبرات والممكنات الإنسانية، التي تمضي لتتدبر جوانية المكان والكائن.
ويسلمنا ذلك تلقائياً إلى تلك العناية التي يتغمد بها القاص الكائنات من حوله، ليتماس معها ويحاورها بما يحفظ لها كينونتها وكرامتها، فالشجرة ليست خلفية محايدة لمشهد ما، بل هي ذات أليفة ودودة، يعرج تأملها بالراوي إلى منهل بديع (أي سحر أي فتنة، بل أي جمال أجدني سابحاً فيه). وكذلك هو الحال مع العربة الموصوفة بمحبة كأنثى بارعة الجمال يكفي أن تعبر طريق ما لتأسر العيون وتدير الأعناق. حيث يمضي الراوي ليصف تفجعه من حتمية فراقه لعربته وبيعها لزبون قد لا يرى فيها أكثر من دابة معدنية ذلول: (نظرت إلى موقعها الأليف في المكان. كان شاغراً هذه المرة تملؤه الوحشة والسكون وشيء آخر كالفجيعة; حزين وقاتم). ولعل كل ذلك يملك أن يمنح بعض تفسير لحفاوة القاص باستدعاء عبارة أثيرة تقول ب(تأمل الأشياء على نحو يخرجها من عاديتها)، وهو عين ما يشير إليه الناقد محمد الربيع وهو يتحدث عن السرد الذي يملك أن يعيد الاعتبار إلى جذوة الأشياء ويستعيدها من العزلة والإهمال.
ولعل جميع ما أشرنا إليه فهذه القراءة يمكن أن يعين على التعرف على ذلك النوع من الإبداع، الذي يرتطم بالتجربة الوجودية ليُصدر ذلك الدوي الرصين، الذي لا يشابه بحال تلك الطرقعة والجلبة التي تصدرها المسكوكات الزائفة.




 myasinplatformltdcom
myasinplatformltdcom