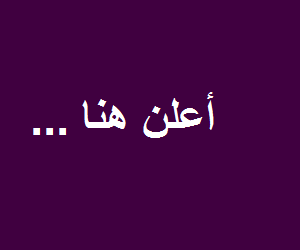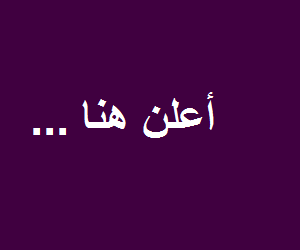زيارة إلى إفريقيا تحية إلى مجذوب عيدروس ومن معه

زيارة إلى إفريقيا
تحية إلى مجذوب عيدروس ومن معه
سعيد بنگراد
في صيف 2018 توصلت بدعوة من الهيئة العامة المشرفة على جائزة " الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي". فقد اقترحوا علي أن أكون عضوا في اللجنة الخاصة بصنف الرواية. وقبلت الدعوة دون تردد. لم أفكر حينها أن الأمر يتعلق بعضوية ستتطلب مني الذهاب لاحقا إلى السودان، لقد كان عملي تقنيا في نظري. وهكذا توصلت بمجموعة من الروايات كان علي قراءتها واختيار ما يبدو لي يستحق الجائزة. وذاك ما حصل. فبعد التداول في شأن هذه الروايات تم الاتفاق على ثلاث منها اقترحت للجوائز الثلاث وتم التصديق على الاقتراح بعد ذلك. وجاءت ثورة السودان. فأخبرت بقرار إلغاء حفل تسليم الجوائز، وانتهى أمر كل شيء.
لكنني فوجئت بدعوة ثانية لعضوية اللجنة ذاتها في 2019. وقبلت الدعوة أيضا. وقمت بما كان علي أن أقوم به. ولفترة شهر أو أكثر كان "منسق" اللجنة، الذي لم أكن أعرف هويته، هو من يقوم بالتنسيق بين أعضاء اللجنة الذين لم أكن أعرف أحدا منهم أيضا. وكان هذا المنسق يقوم بمهمته تلك باقتدار ومرونة كبيرين. فقد باشرنا عملنا بحرية واستقلالية وراحة بلال. وانتهت أعمال اللجنة. وسلمت النتائج وانتهى الأمر فيما استفتينا فيه.
لكنني سأتوصل مع منتصف يناير من 2020 ببطاقة السفر إلى الخرطوم عبر القاهرة لحضور احتفال تسليم الجوائز. كان قراري في البداية حاسما: سأعتذر للأخوة في السودان، وأمنياتي لهم بالتوفيق، فما كان مطلوبا مني قمت به. كان السودان يبدو لي بعيدا جدا، قَدَر ما من الجغرافيا قذف به في أدغال إفريقيا بعيدا عن تاريخه في اللغة والثقافة. ولكن "المنسق" ظل مصرا على سفري، ولم يكترث بترددي في الرد على رسائله، بل وصمتي الطويل أحيانا. ومع إصراره وبتشجيع من بعض الأصدقاء قررت الذهاب وأنا في حيرة من أمري، فأنا لم "أسافر" إلى إفريقيا في حياتي كلها، وهذا كان إحساسي. فنحن ننتمي إلى المغرب العربي الذي هو جزء من كتلة ثقافية مستقلة في اللغة والثقافة موجودة في تاريخ يتحرك خارج الجغرافيا.
كانت الرحلة ممتعة حقا، واستُقبلنا في المطار في القاعة الشرفية الخاصة بالزوار الرسميين، أي الفيب. كان في استقبالنا مسؤول عن شركة الاتصالات "زين"، وهي الهيئة المشرفة ماليا على الجائزة. ومن القاعة أخذونا مباشرة إلى فندق ضخم قيل لي إن القذافي، غير المأسوف عليه، هو من شيده في الخرطوم. وكان فندقا فخما فعلا يتوفر على كل المرافق، وكان الموظفون في غاية اللباقة، كل شيء بدا لي جميلا وكان شوقي إلى النيل كبيرا.
في صباح الغد فقط سأتعرف على المسؤولين عن الجائزة. فقد جاءنا شخص بسيط ووقف أمامنا وحيانا بلطف ورحب بنا كثيرا. واعتقدت في البداية أنه موظف من الذين يدبرون تفاصيل الجائزة في اليومي. إلى أن بادر أحدهم وقدمه لنا باعتباره الأمين العام للجائزة، فهذا الرجل الصموت الكثير الابتسام هو مجذوب عيدروس، بقدره وجلاله. وسأدرك بعد ذلك أن تلك هي ميزة السودانيين جميعا، فأنت لا تعرف من الآمر ومن المأمور، من الذي يتبوأ منصبا كبيرا ومن يقوم بأعمال التدبير المباشر. كلهم يتفانون من أجل خدمة ضيوفهم وإنجاح ما يقومون به. ويفعلون ذلك بدون تكلف وبدون اعتزاز بالنفس، إنه سلوك متأصل في نفوسهم.
وعيدروس هذا من الأقلام المحترمة في السودان، فهو أديب ومثقف وناقد وإعلامي وأمين عام لرابطة الكتاب السودانيين وفاعل جمعوي، ويقوم بمهام أخرى. و كان هذا الرجل هو مهندس الجائزة والساهر عليها، وكان هو المنسق لأعمال كل لجانها. لقد قام بكل ذلك دون أن يقول لنا ولو مرة واحدة إنه هو المسؤول عن الجائزة ومنظم احتفالات تسليمها، وكان يقوم بكل هذا بالكثير من التفاني. وهنا سأدرك أن هذه الجائزة لا تشبه الكثير من الجوائز. لقد اشتغلنا لأسابيع بدون تدخل وبدون توجيه وبدون اطلاع على أسماء المرشحين. كانت الغاية واحدة في كل اللجان: علينا أن ننتقي أجود منتوج أدبي يليق باسم هذا البلد وتليق باسم صاحب الجائزة وبتاريخ السودان كله.
وفي اليوم الثاني بدأت فعاليات الجائزة، فقد كان الساهرون عليها ينظمون ندوة على هامش تسليم جوائزها تتناول قضايا فكرية وأدبية وسياسية. كان الحضور كبيرا، كان هناك المثقفون والسياسيون والطلبة وأساتذة الجامعة. غصت القاعة بالناس من كل الأعمار ومن الجنسين. وهو أمر لم يعد مألوفا عندنا إلا في النادر من الحالات. وكانت محاور الندوة غنية وكانت ثيماتها متنوعة أيضا. أشياء كثيرة كنت أجهلها عن السودان في التاريخ والثقافة وعن شدة ارتباطه بالإرث الحضاري العربي، ولكن كان هناك أيضا تشبث بموروث القارة الإفريقية في كل المجالات، وهو ما لا نلمسه نحن في ثقافتنا إلا في حالات نادرة ( مجموعات "كناوة" مثلا، وهم بقايا إفريقيا في فضاء تغلب عليه الثقافة العربية).
وبدأت أكتشف الوجه العميق للسودان. لم يكن هذا الأمر غريبا عني، فقد درَّسنا في المغرب سودانيون كثيرون، لعل أبرزهم وأكثرهم شهرة كان هو عبد الله الطيب. فقد كان الطلبة يتعاملون مع هذا العلامة حقا باعتباره عالما وفقيها ووليا صالحا وأستاذا مربيا. كان يتمتع بمكانة خاصة في المغرب. وكانت رواية الطيب صالح " موسم الهجرة إلى الشمال" ضمن مقرراتنا في كلية الآداب بفاس أيضا. بل كان بعض الطلبة يحفظون مقاطع طويلة منها. والسودانيون كثيرون في المغرب، بعضهم جاء للدراسة، والبعض الآخر يشتغل في الصحافة، لعل أشهرهم طلحة جبريل الذي أصبح جزءا من المشهد الإعلامي المغربي.
وكان يوم تسليم الجوائز مشهودا فعلا. فقد أُقيم في قاعة يقال لها " قاعة الصداقة". كانت قاعة كبيرة جدا تتسع لآلاف الحاضرين وكانت مملوءة عن آخرها. لم أرَ في حياتي جائزة تجمع حولها هذا العدد الكبير من الناس. لقد كانت لحظة احتفالية وليس مجرد تسليم جائزة. كانوا فرحين بأنفسهم وفرحين بثورتهم وتاريخهم. وجاءت الجائزة لكي تكلل هذا الفرح بحفل كان غنيا في كل شيء: في الحضور وفي الموسيقي وفي تنوع الحاضرين.
وما يثير الاهتمام هو الجهة التي تمول الجائزة. إنها شركة زين للاتصالات. وهي حالة نادرة في الوطن العربي، وقد عبرت عن ذلك في الكلمة التي ألقيتها باسم اللجان. فالرأسمال لا يثق في الثقافة إلا في النادر، ولكن هذه الشركة كذبت هذا الحكم. كان مديرها العام حاضرا ، وكان رجلا بسيطا، يتكلم العربية بطلاقة، وكان يبدو منغمسا في الجائزة وقد حضر فعاليات الاحتفال من أول يوم فيه إلى آخر يوم، لم يكن مجرد مجرد محسن يقدم مالا للثقافة، بل كان مثقفا فاعلا فيها أيضا.
وكان سفير المغرب حاضرا أيضا. واسمه ماء العينين، ابن الصحراء والوجه الديبلوماسي المشرق في السودان. كان المغاربة الفائزون بالجوائز ثلاثة، في الرواية وفي القصة القصيرة. وكان فرحا مزهوا بذلك. كان هو عميد الدبلوماسيين العرب في الخرطوم. بل إنه يتمتع بسمعة كبيرة في أوساط المثقفين السودانيين كما علمت بذلك من أفواههم في أحاديث جانبية. لم يكن يمثل المغرب في الدبلوماسية فحسب، به كان صوته الثقافي أيضا. وسأدرك بعد ذلك عندما دعاني إلى مطعم، مدى سعة ثقافته وتنوعها، فهو مهتم باللغة وبالتعدد الثقافي، وحدثني عن مشاريعه الآتية في الكتابة.
وبدأت أحلامي تكبر شيئا فشيئا. لأول مرة أدرك أنني في إفريقيا خارج وطني، وأنا في زيارة لبلد لم أفكر أبدا في زيارته. كانت القارة الإفريقية من قبل تبدو لي بعيدة جدا، وهي قارة لا أعرفها إلا في الجغرافيا. أما السودان في وجداني فقد كان عربيا في التاريخ واللغة وفي التراث المشترك. وليس غريبا أن يطلق المغاربة على المهاجرين السريين في المغرب من الساحل والصحراء في الكثير من الأحيان، أو في جميعها، "الأفارقة". فنحن أفارقة بالعقل وحده، أما بالوجدان فنحن ننتمي إلى فضاء عجيب يتحرك خارج محددات الجغرافيا. إن انتماءنا الجغرافي مغاربي، فنحن جزء من كتلة ثقافية ممتدة من موريتاينا إلى التخوم القصيىة لليبيا. وقد سمانا المؤرخون قديما "الغرب الإسلامي"، لقد كان هذا الفضاء في تصورهم جزءا من "أمة عربية إسلامية" يوحدها الفكر والثقافة والدين واللغة وذاك هو انتماؤها. إنه فضاء يعج بالتاريخ، ولكنه محروم من امتداده الجغرافي. لقد تعلمت في السودان ولأول مرة كيف أنتمي إلى إفريقيا كما استوعبها السودانيون، لا كما هي في ذاكرتي التوبوغرافية.
أما نيل السودان فآية أخرى، لقد حافظ على "بريته"، وكنت قد سألت أحد مرافقينا من المطار إلى الفندق هل يمكنني رؤية النيل فأجابني، إنه يجري تحت أقدام الفندق. تشعر وأنت في الخرطوم التي يشقها نيلان أحدهما أزرق والثاني أبيض، أنك في الريف، في البادية، كل شيء على طبيعته. فالنيل ينساب بهدوء على مرمى البصر، وكان يفعل ذلك منذ آلاف السنين ولم يغير أبدا من مجراه. كان هذا المنظر آية في الجمال. لم يكن هو النيل الذي ابتلع مصطفى سعيد، بل هو نيل طيبوبة أهل السودان.
وفي اليوم الثالث ركبنا الباخرة، وانطلقت تشق عباب النيل، وتناولنا فيها الغذاء وواصلنا الأنشطة الخاصة بالجائزة. ويومها أيضا أدركت تعدد الأبعاد الثقافية عند السودانيين وتنوعها. لقد جاؤوا بفرقة موسيقية متخصصة في كل التراث الغنائي السوداني، كان أكثرها دفئا وحنانا، عندي على الأقل، هو الألحان النوبية. لم تكن تكن هذه الفرقة تغني لكي تطرب السامعين، بل كانت تفعل ذلك لتكرس التعدد في وجدان الناس.
أدركت أيضا أن الشعب السوداني غني بثقافاته لا بأعراقه، فالعرق خدعة، أو هو تصنيف تنكره حقيقتنا في الزمنية الإنسانية. فالإنسان لا يعيش شرطه على الأرض ضمن إكراهات عِرقية سابقة على وجوده في الثقافة. لذلك كان العرق مبررا ل"شرعية" تستند إليها الإيديولوجيات اليمينية المتطرفة من أجل ممارسة عنصريتها في الفضاء العمومي. إنه لا يشير إلى التعدد والتنوع، كما يبدو عليه الأمر في الظاهر، بل يكرس الأفكار الخاصة بــ "التفوق" و"التحضر" ، لذلك كان في أغلب الحالات سببا في القضاء على التنوع الثقافي الحقيقي الذي يؤكد غنى الوجود الإنساني على الأرض، في الثقافة وفي أنماط الحياة وفي تدبير القلق الوجودي أيضا.
وفي اليوم الأخير من الزيارة انطلقنا في رحلة أنا والروائي طارق الطيب وزوجته النمساوية لزيارة بعض مناطق الخرطوم. وكان هذا الرجل مصريا سودانيا نمساويا، ولكن السودان هو الغالب عليه، في طيبوبته وفي بساطته وفي ثقافته وعمق رؤاه. ولد في مصر وترعرع فيها وهاجر إلى النمسا وتبنى ثقافتها، ولكنه ظل مشدودا إلى السودان، وله مجموعة من الروايات. كان مجذوب عيدروس مرة أخرى هو دليلنا في رحلتنا داخل الخرطوم . لقد جابت بنا السيارة الكثير من أحيائها وتعرفنا على بعض معالمها وحدثني في هذه الرحلة عن كرامات الصالحين المغاربة الذين استوطنوا السودان. بل هناك تجمعات سكنية أهلها كلهم مغاربة.
وشربنا الشاي والقهوة ومشروبات أخرى لا أذكرها عند " ست الشاي". كانت امرأة من جنوب السودان، ولكنها لم تغادر شماله. لم تكن هي أو مرافقي يشعرون أنهم ينتمون إلى بلدين مختلفين، مازال الجنوب حيا في وجدان الناس، ولم يصدقوا أبدا أنه ضاع. لا يتعلق الأمر عندهم بضياع قطعة من وطن، بل بتمزق أصاب الجسم الثقافي والسياسي والاجتماعي السوداني. شيء ما اختفى من عبق التاريخ والجغرافيا في السودان مع هذا الانفصال. حينها أيضا استحضرت صحراءنا التي يريد البعض اقتطاعها من وطننا، فالصحراء هي بوابة إفريقيا عند المغاربة، وهي ما يسهم في ثرائهم الثقافي أيضا.
وقد أدركت ذلك أثناء المحاضرة التي ألقتها أستاذة حول المشهد السياسي في السودان. كان هناك في صةتها ةتحليلها أمل في عودة الأبناء إلى وطنهم. لقد انفصل الجنوب، ولكن لا يبدو أن الشعب السوداني استوعب هذا الانفصال، فما زال الجنوبيون يشعرون بأنهم في وطنهم. وقد أثارني يوم تسليم الجوائز تصريحا جاء على لسان فرانسوا ديغ، وقد كان "ضيف الشرف" في هذه الجائزة وهو مواطن من جنوب السودان. قال وهو يلقي كلمته : " وأنا أضع أقدامي في مطار الخرطوم أحسست بأنني أعود إلى الوطن الأم". لقد كان سودانيا وسيظل كذلك، في هذا البلد ترعرع ومن جامعاته حصل على شواهده الأولى، ولكنه سيكون جزءا من وطن آخر بعد الانفصال.
وفي يوم الجمعة تذكرت رحلة العودة. كان علي أن أستعد للسفر. لم أفرح كثيرا كما كنت أفعل دائما في رحلاتي خارج الوطن. تمنيت لو أبقى أياما أخرى في السودان، كنت أريد أن أتعرف على مثقفيه وإعلامييه، بل كنت أتمنى أن أزور جامعاته وأتعرف على طلبته. لقد دخلت السودان مترددا خائفا، ولكنني خرجت منه حزينا آسفا، وأملي أن أعود إلى تلك الأرض الطيبة مرة أخرى.





 aamerm531gmilCom
aamerm531gmilCom