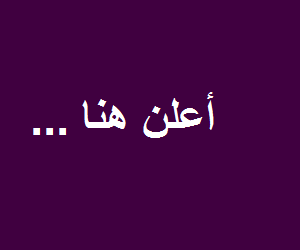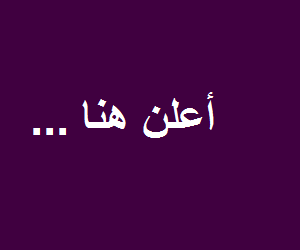بهنس.. هزائم الجيل الثالث (3)
بهنس.. هزائم الجيل الثالث (3) عماد البليك ما بين الأشواق نحو تحرير الذات والخروج عن السلطة التقليدية كان للمثقف أو الفنان كما تمثل في شخصية بهنس أن يواجه بسخرية ومضايقة الوسط الفني والثقافي

بهنس.. هزائم الجيل الثالث (3)
عماد البليك
ما بين الأشواق نحو تحرير الذات والخروج عن السلطة التقليدية كان للمثقف أو الفنان كما تمثل في شخصية بهنس أن يواجه بسخرية ومضايقة الوسط الفني والثقافي، هذا الأمر الذي لوحظ في الأوساط الثقافية السودانية من اللجوء إلى التحزب أو الشللية أو التصنيف المسبق، ما جعل العملية الإبداعية في حد ذاتها أو الإنتاج الإبداعي لا يخضع لمعايير أو شروط معرفية أو أسس سليمة، إنما الأهواء الذاتية والشخصانية.
هذا الأشكال ظل قائمًا ليس لدى جيل بهنس إنما عامًا لدى الأجيال المختلفة في التجربة الثقافية السودانية، ما أدى إلى نتائج قاسية على بعض المثقفين وترتب عنه في مرات عديدة أن تشكل مشهد زائف لحقيقة الثقافة والفكر في الفترة المعينة.
في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى تجربة الشاعر محمد الفيتوري الذي عاد إلى السودان من الخارج في مطلع الستينات من القرن العشرين، ففرض على نفسه عزلته، وسط أفراد معينين رافضًا الاندماج في المحيط الثقافي والأدبي، لهذه العلة المذكورة، وآثر أن يتخذ أصدقاء من أجيال أصغر منه أو أناس خارج هذا المحيط الذي يضج بالخصومات والصراعات.

ثمة من يلحظ أن بهنس عاني من هذا الشيء، ربما كان ذلك واحدًا من أسباب هجرته، بالإضافة إلى العوامل السابقة التي جرى ذكرها من فكرة الاغتراب النفسي والرفض الاجتماعي والرغبة في إثبات الذات.
هناك مسألة أخرى يجب التذكير بها وهي قضية المثقف أو الفنان الشامل التي كان ثمة من ينظر إليها بشيء من الريبة، في ظل الحديث عن خرافات التخصصية والموهبة المحددة في مجال بعينه وإرث الوصايا، وقد انفلت بهنس من ذلك، باعتباره كان متعدد المواهب وكان يبحث عن المعنى لذاته من خلال هذا التنوع في المعاني، فجرب التصوير والتشكيل والأداء التمثيلي الحر والشعر والرواية، وهي فنون متداخلة لو رجعنا إلى البنية الأساسية لها ومفهوم الفن في حد ذاته، بيد أن العقل "الأرثوذكسي" في بنية الثقافة السودانية، كان يريد للفنان أن يكون أحاديًا في التجربة، بحيث لا يسعى إلى التجريب أو إعادة اكتشاف مواهبة المتعددة والتداخل بينها، برغم أن هذا الشيء قائم في تجارب إنسانية عديدة، كما في تجربة اللبناني جبران خليل جبران التي جمعت بين الأدب والرسم. وهذه في نهاية الأمر حرية المبدع في كونه يعمل على التقريب بين أمزجته المختلفة داخل مزاج واحد يتعلق باللحظة الإبداعية التي يعيشها ويكون مخلصًا لها قبل أي املاءات مسبقة على الفعل أو النص أو المنتج الإبداعي.

إذا كانت الخرطوم وقتذاك في التسعينات تضج بالحمى السياسية والردة إلى الأصولية الدينية ونزعات الجهاد، فإن الفضاء الثقافي هو الآخر لم يكن بمعزل عن ذلك الشيء، حيث سعت مؤسسات الدولة إلى توليد بنية جديدة للعمل الثقافي تقوم على الأسلمة أو ما يعرف بمأسسة إسلاموية، ولأجل ذلك تم تأسيس مجموعة مؤسسات تم وسمها بالفكرية، كهيئة الأعمال الفكرية ومركز تأصيل المعرفة وغيرهما، ووسط توقف الصحف وبقاء صحيفتين فقط في البداية، وأيضا انقطاع الحرية في النشر، وفي السينما والفنون عامة، ما عدا الفرص التي تكلمنا عنها وهي تنسج بحذر في المراكز الثقافية الأجنبية، كانت ثمة عزلة حقيقة تفرض على المثقف والفنان، يزيد من شرها الصراع غير الشريف داخل المؤسسة الثقافية نفسها، التي قد لا ترتقي لهذا المفهوم. مع هجرة مئات الفنانين والمبدعين الجادين خارج الوطن بحثًا عن ملاذات جديدة في ظل الضغوط الاقتصادية، ما جعل جملة هذه العوامل تتضافر لتدفع أي فنان حر ومثقف واعٍ يبحث عن تأكيد لمشروعه أن يفكر في "التحرر الذاتي" عبر الهجرة والاغتراب المكاني.
في واحدة من المسائل المعقدة والأشكالات الكبيرة داخل بنى الوعي الثقافي الجمعي السوداني، ثمة رغبة دائمًا نحو تأكيد المؤكد وعدم الاعتراف السريع بالتجارب الجديدة، ليس لدينا مناخات حداثوية في الفكر الحرّ والحرية الفنية والإبداعية، هذا بعيدًا عن فعل السياسة، أي في البدء على مستوى الوسط الثقافي نفسه، الذي بات يعمل على نمذجة الأنماط الإبداعية، حتى وصل الأمر إلى صنع قوالب تكاد تكون متكررة للشعر والقصة والتشكيل والمسرح الخ.. ما يعني إغلاق العقل باتجاه التفكير والإبداع الحر، وهذا يقود في نهاية الأمر أي شخص حر المزاج وله من الموهبة والسعي نحو الإضافة؛ إلى ممارسة القطيعة والبحث عن طريق ثالث.
هذا الإرث قد لا يكون سودانيًا بحتًا إنما هو في صميم الثقافات العربية التي تعتقد بفكرة المقدس والنموذج وترى الجرأة على التقليد بمثابة خروج عن الألفة والنظام، فهي ثقافة القالب والتأطير، وهذا سائد إلى اليوم لم يتم التحرر منه، ولا يمكن أن يحدث إلا في إطار مناخ ثقافي حقيقي لا يأتي بمعزل عن مجمل البنى السياسية والاجتماعية وتطوير أدوات النقد عامة، لكن ذلك يتم ببطء في غياب مؤسسات راعية لهذا الفعل يكون طابعها الاستقلالية.

في مجمل هذا المناخ والأبعاد الثقافية والأرضية السياسية والمعرفية المنقوصة، لم يكن لنموذج بهنس في الجيل الثالث إلا أن يعمل على المقاومة الصامتة التي تقود في النهاية إلى الكفران بهذه الصور والمشاهد الملوثة، حيث يكون سعي المبدع إلى البديل أو الجديد من خلال تجريب آخر في الجغرافية ومساحات الإبداع، وهذا ما فعله محمد حسين بهنس، إلى أن يكون ذلك الختام الحزين في 12 ديسمبر 2013 بأحد أرصفة ميدان إبراهيم باشا بالعتبة في العاصمة المصرية عن 41 عامًا، على أعتاب مرحلة جديدة من السلوك الروحاني والأداء العارف بالحياة والانتباه للأشياء.
هنا بهذا الجزء نكون قد وضعنا الإطار الجدلي العام الذي تحركت فيه التجربة والممارسة والأشواق لقصة مستمرة في نماذج المبدعين "المتمردين" سواء تم ذلك بصمت أو بمواجهة علنية مع المجتمع أو الوسط الأدبي والفني والثقافي، لنشرع بعد ذلك في التحليل السيري لتلك الحكاية الواقعية لهذه الرحلة ومن ثم الإنتاج الإبداعي من حيث أنواعه ومقولاته وكيف يتقاطع مع مشاهد العصر واللحظات الزمنية التي أنتج فيها، وما هي الرمزيات والدلالات التي حملها، في إطار نقد الواقع والبحث عن الرؤى الإنسانية والجمالية الجديدة، في مشروع تتعدد مشاربه ويأخذ من الأطياف المتنوعة لفكرة الفنان الشامل، الذي لا يؤمن بسوى الفن كرسالة "الفن للفن" دون أن يصارع الجدل الاجتماعي مباشرة، أو ينتصر للذات على حساب المضمون.

كيف كان ذلك قائمًا في مشروع بهنس الجمالي والإبداعي وفلسفته عن الحياة والوجود والمعنى، وكيف تطور؟ وهل سنقرأه اليوم بذات التصور الذي كان قبل عشرين إلى خمسة عشر عاما، في قراءة معاصرة تشبه الواقع الجديد اليوم؟.. هذا ما نتابعه في مقبل السطور..




 myasinplatformltdcom
myasinplatformltdcom