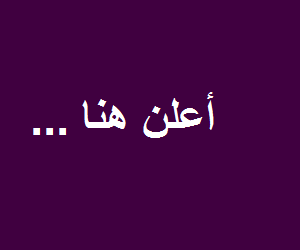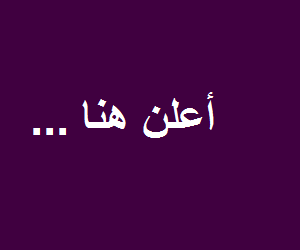حفريات ذاكرة الحوت: تشييد المعمار السردي على قاعدة أساس المحكية العامية
حفريات ذاكرة الحوت: تشييد المعمار السردي على قاعدة أساس المحكية العامية الدكتورة.. ليمياء شمت (ألم نلحظ بعد أننا جميعا أوراق ذات الغصن .. نقاط ذات النبع؟!) جين باتسبي يطمح العمل الإبداعي الروائي إلى اقتناص لحظة مما يلابس حياة الناس، ومن ثم معالجتها سردياً لتتحول إلى برهة إنسانية مضيئة، تملك أن تشع بجوهرها الخاص، الذي يجاوز بها حدود زمانها ومكانها لتمخر عميقاً في صميم الوجود، والمشترك الإنساني. وهكذا تصبح الكتابة، وفقاً للمباحث السردية، نصاً كونياً خارج حدود الذات، ومحابس الزمان والمكان. وذلك هو تحديداً رهان رواية "حفريات ذاكرة

حفريات ذاكرة الحوت: تشييد المعمار السردي على قاعدة أساس المحكية العامية
ليمياء شمت السودان
(ألم نلحظ بعد أننا جميعا أوراق ذات الغصن .. نقاط ذات النبع؟!)
جين باتسبي
يطمح العمل الإبداعي الروائي إلى اقتناص لحظة مما يلابس حياة الناس، ومن ثم معالجتها سردياً لتتحول إلى برهة إنسانية مضيئة، تملك أن تشع بجوهرها الخاص، الذي يجاوز بها حدود زمانها ومكانها لتمخر عميقاً في صميم الوجود، والمشترك الإنساني. وهكذا تصبح الكتابة، وفقاً للمباحث السردية، نصاً كونياً خارج حدود الذات، ومحابس الزمان والمكان. وذلك هو تحديداً رهان رواية "حفريات ذاكرة الحوت" للدكتور محمد عثمان الجعلي، الصادرة مؤخراً عن دار مدارات للنشر، حيث توظف الذات الساردة خبراتها الوجودية والإبداعية والمعرفية ليتفرد السرد بدمغته الأصيلة، ويغتني بالروافد الحكائية والمدد الجوفي، والمسارد التي تومض بالرؤى والانتباهات الجمالية، واستمطار فواتن الإبداع لتُبث بين ثنايا السرد فتتوهج بها كوامن المعاني ومكنونات الحس، وحيث يتصل تذخير المحكي بترياق الشعر والمسادير وعذوبة الغناء وأنس الحكايا وحصافة المأثورات، بينما تتعالى حمحمة صدور خيل المروي وهي ترمح لأعالي السرد، وتتصاهل عند مورد الفكرة وغلة الذاكرة، وهي بعد تستقصي وتجس المسالك لاستكشاف الدروب البكر إلى أرخبيل بهار الحكي.
ولابد من الوقوف بدءاً عند أهمية وجوهرية الحوارية العامية في رواية "حفريات ذاكرة الحوت"، والتي تمثل المادة الحكائية الأساسية التي تنتظم بها بنية السرد. فالقارئ لا يلبث أن يلاحظ أن الحوار يشغل حيزاً مقدراَ من السرد، حيث يتم توظيفه كعنصر حاسم وكنسق شامل ينهض به البناء الروائي. فهو يمثل مركز توجيه يدير شبكة العلاقات النصية، ويرفد منطقها الداخلي ويغذي أمشاجها الباطنة. وهكذا يمكننا القول بأن الحوار العامي يشكل لبنة أساسية لتركيب جل المعمار الداخلي للمحكي. ولعل ذلك يعود بشكل رئيسي لحيوية الحوار وطواعيته، وقدرته على الاستيعاب والاحاطة. فحينما يختار الكاتب الروائي أن يكون الحوار باللغة العامية المحكية، فإن ذلك يعني بالضرورة أنه قد وطد عزمه على مواجهة تحدي استخدام اللغة في مجالها الحيوي، في أكثر مستوياتها واقعية وصدقية، ومن ثم استثمارها كتصوير نابض لليومي في دورته المركبة، في كنف حاضنته الاجتماعية متصلاً بأوردته الحياتية، سيما وأن وقائع الرواية تدور في أحد الأحياء الشعبية، وتزخر بالتالي بشخوص وملامح تلك البيئة وموجوداتها ومشاهداتها.
وذلك ربما ما مكَّن للغة الحوار العامي في ذاكرة الحوت من أن ترصد وتوجه وتضبط ، بل وتؤنسن وتبوصل، وتؤزمن وتؤمكن بفاعلية قصوى، لينهض حقل السرد من بذور تلك الحوارية تركيباً وصياغة وسبكاً ودلالة. وهكذا يمكننا أن نخلص في هذه الجزئية إلى أن الحوار العامي قد تم توظيفه كما أسلفنا كناظم إبداعي وكقطب مركزي منح السرد خصوصيته الأسلوبية، وعزز ثنائية الأثر والتلقي باستدراج مألوف الذاكرة وخزينها لنسج حميمية القارئ مع النص، ليلتئم بذلك مع حياة وشخوص ذلك الفضاء الأليف، مع الاحتفاظ له بملكية مسافته التأويلية الجمالية.
وتشمل مركزة الحوار تفعيل عنصر الحدث عبر استخدام الحوار كتقنية سردية لبناء الحدث وتركيب الوقائع، والقبض على التفاصيل. والجدير بالرصد كذلك أن الحوار يسخَّر لإعادة انتاج علاقات السرد عبر اللغة العامية، بحيث يمثل الحوار دينمو لتوليد الأحداث والمواقف الدرامية. كما يستثمر كذلك في البناء المشهدي ورسم الخلفيات الزمانية والمكانية. ولهذا فإن الحوار لا يقتصر على تركيب المعمار الداخلي للمحكي، بل ويسخَّر كقادح سردي ينحت مجرى الحكي ويعمل على تجويد سبك التفاصيل، وشد خيوط السرد إلى نقاط ذات طابع كشفي. ومثال ذلك بعض الأحداث المفصليةً والتي تُفشَي للقارئ عبر الحوار مثل حادثة انتحار زوجة الطاهر مع ولديها، والذي يُكشف للقارئ في الحوار بين فضل المولى وود البشير (بت بادي بعدها بيومين حرقت نفسها وماتوا معاها الولدين الصغار). وكذلك هو الحال بالنسبة للطاهر فبرحيله عن الحياة، والذي يفضي به إلينا صديقه محمد زين في حواره مع ود الطاهر يوم سماية مولوده (مبروك الوليد ياعبدالله وإن شاء الله يتربى في عزك. .قالوا سميتوهو الطاهر.. والراجل السميتو عليهو راجلاً ما ساهل.. الله يرحمك يا الطاهر.. إن درت الرجالة.. إن درت الكرم.. إن درت الفهم.. إن درت الجودية.. إن درت الخوة).
أما فيما يخص الشخوص فإن مما يمنح الحوار مركزيته أنه يُوظَف كمكون بنائي جوهري للشخوص يستوعب أبعادهم النفسية والعاطفية، وتحولاتهم الحياتية والفكرية. فالحوار يُبدع بإحكام لاستكناه خبايا الشخوص، وتعزيز وتكثيف ملامحهم. حيث يتجلى الحرص على مواءمة اللغة لتتسق مع بيئة الشخوص وتجاربهم ونضجهم الإنساني. وهكذا يتم تسخير منطوقهم اليومي بحذق في تعميق حضورهم، دون تغريبهم عن سياقهم الحياتي، لتظل اللغة مؤتلفة مع مرجعياتهم الاجتماعية والثقافية. فمثلا نلاحظ أن الحوار بين الشخصيات الأنثوية من ربات البيوت يحدب على اختراق الذاكرة الحريمية البيتية بانشغالاتها المختلفة، مثل الاعتناء بالتفاصيل والتقاط الإشارات، ونزعة الوصف الدقيق الرصاد، واللغة الروية المسجوعة.
وهنا نصغي لحاجة ست أبوها وهي تشمل الطاهر بجوارها البار (يا خوي نحن الربنا يقدرنا على جزاك يا أب ضراعاً وافر ويا اب خيراً دافر..أياكا ضونا وركيزتنا..أنت راجية الله ياخوي نارك ما تنطفي وقدحك ما ينكفي يا العطاي ويا الأداي). أما في حالة تجمع المثقفين فإن اللغة المستخدمة في الحوار تعكس أفكارهم وبطانتهم الايدلوجية (..شوية الوعي دا يا عبدالله ما ادا الناس كل البصر المطلوب لكن أداهم شوية نظر تخلي الناس تكابس وتلقا ليها مخرج.. خلافاتنا نحن عشان ما أكون متحيز حأترك الكلام عنها لأي واحد من الزملاء بعد ما تقعد معاهم في اجتماع بكرة). وكذلك فإن الحوار يستخدم كذلك لاستيفاء البناء الداخلي للشخوص، مع الايغال في إضاءة حالاتهم الشعورية بعبارات موزونة الصياغة، بسيطة ودالة، وفي ذات الوقت كاشفة تجيد الغوص تحت الأسطح النفسية والوجدانية.
ولنقف على سبيل المثال عند شخصية عبدالله ود الطاهر الذي يذكرنا بمقولة برتراند رسل (الوقت الذي نستمتع بإضاعته ليس وقتاً ضائعاً). وهو يفصح جهرة عن أشرعته المواتية التي تحركها رياح المغامرة، وعن نوازعه المتناقضة، ونزقه انفلاته، وتدحرج نرده على طاولة المغامرات والنزوات دون رادع. وتتجلى براعة السارد في إبداع شخصية ود الطاهر بتناقضاتها الصارخة وعمقها وطويتها الإنسانية العامرة. فبالرغم من تورطه في تلك الشواغل الطائشة، إلا أن السرد لا يقدم نموذجه البشري على مسَلَّمَة ازدواجية قالب شقيه الطيني والنوراني، بقدر ما يشتغل على تحليل تلك الجوانب الغائرة والمعقدة للطبيعة الإنسانية. والتي تتجلى في الطريقة الفريدة التي يصوغ بها ود الطاهر علاقاته مع الناس من مختلف مشارب الحياة، وفلسفته الخاصة في الصحبة والمتعة والمؤانسة. بالإضافة إلى الحرص عبر تسلسل المسرود على تسليط بؤرة الضوء على وعيه الحاد وإحاطته المقدرة بما يمور حوله من أحداث، وريبته الفطنة، وقدرته الهائلة على السبر والتحليل والمقارعة، وخلخلة الأفكار الجامدة، بل وتلخيص أعقد الرؤى، دون أن ينفلت ذلك من قلم الكاتب ليتحول إلى خطب أو وعظ ومرافعات جافة. ولنصغي لصوته وهو يتحدث عن مقاومة الاستعمار (أكان الشعر بسوي شيء شعر خليل فرح وتوفيق صالح جبريل كان مرق الإنجليز زمان.. البلد دايرا ليها مكن وحديد وجبخانة.. دايرا تيراب وأولاد علي عبداللطيف وعبدالفضيل الماظ..يا اخوانا الزمن زمن المكسيم والمدفع أب ثكلي). وهكذا تتجلى عبر الحوار المهارة المتوخاة للاحتفاظ له بلغة بسيطة متهكمة كاشفة،لا تتجشم عبء التخفف من لسع سخريتها الهاتكة. فلا عجب أن حتى من يعارض ود الطاهر ويتسخطه لا يملك إلا أن يشهد له بالمروءة والإحسان والجرأة غير الهيابة، (يا ست أبوها الناس بتحكم بالظاهر.. الخير الفي الولد دا يتقسم على مية راجل ويفضل.. راجل يملا العين، ضكرنة ومروة وشجاعة.. وان بقت على خمج الشباب ربنا بيهديهو).
وكذا هو الحال مع شخصية والده الطاهر الذي يتم تقديمه بأناة سردية ماتعة ليبدو كشجرة راسخة، رأسها في العواصف وجذرها في اليقين. حيث يستبطن بناء الشخصية الوئيد إيقاع السرد ويتماهى معه. فيتم وفقاً لذلك الإطلال على مشهد الحياتي للطاهر بنظر متمكث طويل النفس. لكن الأمر ما يلبث أن يتحول إلى تواتر سريع، يبدو كقفزة سردية خلفت وراءها فراغاً وأمامها غباراً حاجباً، تحديداً في الثلث الأخير من الرواية، وبعد قرار زواجه الجسيم. وذلك لغياب تواطوء الوقائع والتفاصيل الذي يستوعب تلك الاحتمالات ويمهد للقارئ التكيف معها. ومن ذلك تردي الطاهر المفاجئ في شباك الغواية، وانحسامه الفاجع على حد الفتنة، دون تحول تدريجي يشي بتصدع رصانته المعهودة، أو يمهد لتشوشه واضطرابه في الحكم على الأشياء، أو حتى تبيان مقتصد لحيثيات ترجيحه لخيار يجعله يقف رغم حنكته الراسخة على شفا هاوية فاغرة.
فالقارئ لا يكاد يجد في طي تلك الأحداث ما يعينه على التعاطي مع ذلك الموقف الشائك، أو التوافق مع ذلك الاندفاع الحكائي المتهدج، على حساب إيقاع الحكي وقوة سبكه. حتى كاد ذلك التسارع أن يطمس ما تعود عليه القارئ من وهج الحكي وبهجته العميقة، لولا شفاعة واقعة الحلم التي ارتبطت بوقائع تلك الليلة الفارقة، وما أوحت به من إشارات مثل تفويته لصلاة الفجر، مع إيحاءات تلك الرؤية المنامية التي يرى الطاهر فيها ابنه بائساً مشعثاً، بينما تلوح سعدية الحلبية ضاحكة فرحة. ومن ثم ربط كل ذلك بوشائج الغيبي والتنبؤي ليعمل كتمهيد لما يليه من بلايا. وهنا أيضاً يتبادر للذهن السؤال عن سر التحول من سياق العامي للفصيح، حيث يتكفل شيطان زوجته المُحرض بمحاورتها بالفصحى،(ماذا بقى لك يا امرأة.. أهلك؟ لقد جعلهم يتبرأون منك.. أطفالك؟.. يُفع صغار لا حول لهم ولا قوة.. ما مصيرك إن بقيتي معه؟)، ضمن ذكريات تلك الغضبة المنذرة التي طوحت برشدها، إذ يبدو الطاهر منخرطاً في استدعاء طيف زوجته الراحلة،(رغم كافة مآسي ذلك اليوم المشئوم إلا أن تلك النظرة المتحدية المستفزة المحتقرة المشمئزة تظل أبرز معالم ذلك الكابوس المرعب الذي هد كيانه وزلزل حياته)، وكأنه يتملى بإلحاح كل تلك التفصيلات ليستوثق من جنونها الفجائي، فيتعزى ويواسي نفسه ويهدهد شهقات ضميره.
ولابد لنا أن نعاين كذلك أهمية (قال الراوي)، والتي يستخدمها الكاتب في مفتتح بعض الوحدات السردية كأداة استهلالية تعمل بدقة إزميل سردي ينحت البؤر والمتواليات الحكائية التي ينطلق منها الحكي في مسارات متشعبة. كما أنها تعين على نقل التركيز الروائي من حيز إلى آخر، لالتماس فضاءات تقع وراء الفيزيائي المتعين. وتسهم كذلك بفاعلية في تحريك كاميرا السرد، مما يتيح الزحزحة والمونتاج الزمني وكسر التراتبية. كما تستخدم أحياناً كرابط عضوي أو كخيط شفاف خفي لحبك وحياكة ما قد يبدو كأطراف متنائية للوحدات السردية المتلاحقة. ومن ذلك توظيفها في استحضار بعض الحلقات المفقودة، وخلفيات الشخوص، وربطها بإلإحالات المتسلسلة عبر دفق المحكي. وذلك يفسر بدوره ما قد يغلب عليها من صبغة إخبارية قد تحيل إلى شخص أو موقف. لذا فعادة ما تكون ذات بنية تركيبية دلالية بسيطة. ورغم الحرص على النجاة بها ما أمكن من عواقب الثقل الإخباري، إلا أن الاستخدام المتكرر والزائد أحياناً قد جعل النص يخسر بعضاً من حيويته وطمأنينته الحكائية المعهودة.
ويعود ذلك بنا تارة أخرى لمركزية الحوار وما ظل يحدب عليه الكاتب من صقل لغوي، وبناء جريء للجملة العامية. فهو لا يكتفي بأن لا يغمطها حقها في الحضور الكامل الباهر غير المعتسف، بل يكدح إبداعياً ليمنحها حق الوجود المكتمل المؤثر، دون أن يصرم روابطها بالفصحى، ليتجلى عبر السرد ذلك التكامل المتسق، الذي تكتسب منه العامية ألقها الخاص من خلال وجودها في فضاء الفصحى، وتتجمل بمرونتها الفصحى في تحالف منتج دلالياً وجمالياً. فاللغة تنبجس تلقائياً من بعضها، وتهب بعضها البعض طاقة الحضور والنفاذ. وتظل تترافد وتتلاقح في حقل السرد بما تختزنه روافد كليهما من ثراء. وهكذا فإن الرواية تفلح في أن تعقد قراناً مباركاً بينهما، خاصة بما يتجلى به العامي في التصاقه الحميم بالحياتي اليومي. ولنتمعن على سبيل المثال الحدس اللغوي الرهيف الذي نقع عليه فيما تضمره دلالة "أخينا" و"أخوانا" من معانٍ يدركها ذهن التاجر ختم في تعامله مع شخصية الطاهر، (في تلك المناسبات كان الطاهر يمد يداً باردة لتحيته وهو يقول "أهلاً يا خينا " بدلاً عن "أهلاً أخوي" و"مرحب حباب أخوي" التي كان يقولها لغيره.. في مثل تلك الأحوال فقط يدرك ختم أهمية وخطورة اللغة). وهي انتباهة تتراسل إنسانياً مع محكية (رأيت رام الله)، التي يوثق بها مريد البرغوثي قصة العودة عقب ثلاثين عاماً من النفي لحضن موطنه في رام الله. حيث يحكي ما أصابه من أذى معنوي والرجل النحيل يناديه "تعال هون يا أخ" ليزفر البرغوثي بتعليقه الأسيف: ليس هناك ما هو موحش للمرء أكثر من أن يُنادى عليه بهذا النداء "يا أخ". فهي بالتحديد العبارة التي تلغي الأخوة".
وكما أسلفنا فإن قالب الحوار العامي قد أسهم بحيويته وحرارته وسلاسته وتداعيه العفوي في هندسة الإيقاع السردي، وخلق امتدادات طبيعية ونقاط وصل وتنامٍ للمحكي، وذلك عبر تمريرات بينية بارعة، وتبادل وتناوب وتقاطع واستطراد حواري شديد التضلع والحصافة. فقد تفانى الكاتب في استثمار دوائر طاقة اللغة العامية، والاستمداد من خزينها الجمالي وسحتها الدلالية لإمتاع القارئ وتمكينه من التلذذ بنكهة الكلمات المستودعة في نبرها وايقاعها ونبضها ومسارب ذاكرتها، وكذلك النهل الحلال من مورد الفصيح بطاقاته الكنائية والإلماحية الباهرة. ويتوجب هنا كذلك الوقوف عند خاصية تحرير النص من الإسهاب الإنشائي، بالاستثمار البصير فيما يمنح السرد نضجه وصدقيته. إذ يبرع الكاتب في لملمة أوسع الدلالات في عبارات بارعة مقتصدة دالة وقوية البناء، وخالصة من الزوائد، (زهرة بت رجب هي امرأة الهامش.. جنحت في مسقط رأسها.. فلما أثمر الجنوح خافت الفضيحة.. هربت بمولودها من صحراء القرية وشفافيتها وتدثرت بضبابية المدينة وغشاوة نسيجها الاجتماعي). فحتى التفاصيل التي قد تبدو للوهلة الأولى طفيفة وعابرة، تومض حثيثاً في ثنايا السرد لتكشف الوجه الآخر للأشياء. وبالمثل فإن ما قد يبدو ثرثرات صغيرة يتم كذلك توظيفه بنجاعة لاقتناص اللامرئي، وسبر المطمور في طيات الواقع، لتتمرئى به ذبذبات الانبساط والتوتر الدلالي في عصب النص. وذلك تحديداً مما يسوغ الطول النسبي للحوار الذي يتم تسخيره إبداعياً لتوسيع حدود الممكن السردي وتوطيد أركانه. حيث الاتكاء الواثق على ثراء العامية وكفاءتها التعبيرية، مع العمل على مضاعفة تأثيرها بتذخيرها بطاقات التفكه والتندر والسخرية، التي تكشف تمرس الكاتب وتجويده، (عارف يا ابو الصحب الخواجات ديل بتاعين بونية وبوكس تقول كابويات وأنت شغال لي بي أم دلدوم وام أضان التقول بتشاكل في قهوة أم الحسن).
وهكذا يمكننا أن نخلص إلى أن استخدام الحوار كقطب مركزي ومستلزم سردي حيوي قد منح النص طبقاته الحكائية المركبة المتضامة، وموَّله بالخام الذي يفتح بدوره ممكنات جديدة للمسرود، بتعبيد مساراته في تمددها الزماني والمكاني. في سورة كدح إبداعي مخلص يتصاعد به الحكي بخط متنام على مستوى التركيب والتراكم والسبك، بما يحفظ له تحابكه وتراصفه الدرامي على قاعدة محكي عامي. وهو ما يحتشد ويتراكم عبر الرواية ليتوج ذاكرة الحوت كمنجز روائي فارع يرفع به د.عثمان الجعلي مدماكاً مرصوصاً متماسكاً مع جمال محمد أحمد والطيب صالح وإبراهيم إسحق وبشرى الفاضل ويحيى فضل الله، كمساهمة إبداعية تخلص في ترسيخ ثراء العامية، وكمثال ناصع لكسر سلطة النموذج، والخلق الإبداعي الواثق، الذي يملك إرادة الانفلات من عمى الدوران في ساقية الهجس بمظان الفصيح/العامي في لغة الرواية، والنجاة من أعراض متلازمة ذلك الاحتراز الكابح، الذي ظلت تغذيه هواجس المقروئية والانتشار المترسبة في ذاكرة الإبداع، وأوجال مشروعية العامي في صخب المحاججات النقدية المتضاربة، وما تنجلي عنه من حضور خجول للعامية عبر حوارات قصيرة مقتضبة، تشي بوجلها وعثارها وارتباكها من أثقال متكلفة ينوء بها ضمير الإبداع السردي.
ولا نغفل كذلك عن عافية الرواية كأرشيف وجداني ضاج بالحياة ومفعم بالحس، وما تفيض به من حنين وهّاج لا يستدرج الذاكرة إلى لزوجة فخاخ الاستيهامي والانتقائي المعتاد، في جوف مدار نوستالجي مغلق، بل يخرج بها عنوة من غشاوات الاجترار إلى استحضار استيعابي متدبر، يُخضع سجلات الماضي للتساؤل والتشكك، وإعادة النظر، ليحولها عمداً إلى مراجعة رؤيوية متمهلة وجرد ذهني هادئ متفرس. وهو ما يدعونا مرة أخرى للوقوف لتأمل أسرار تلك الكيمياء السردية التي تم فيها مزج العناصر بمقادير دقيقة لتتفاعل بها أنوية الحكائي في حاضنته المجتمعية والثقافية، في محكية تحتفي بإنسانية الزمان والمكان، وبمكونات النسيج الاجتماعي من مختلف الفئات، والجاليات الأجنبية والأصول المختلفة التي تعمل الرواية على تقديمها كأعراق متداخلة متساكنة. كما تحرص في ذات الوقت على تفادي كل ما قد يكرس للأفكار المتحاملة أو الصور الذهنية المتحيزة والقوالب الجاهزة عن أقوام أو مجموعات بعينها. بالإضافة للتطواف الواسع الثر بشعاب عوالم الشعر والغناء وكرة القدم، وبعض المؤسسات القومية المؤثرة كالبريد. وهناك أيضاً البيوت الطائفية وتيارات الحركة الوطنية والخريجين والأحزاب والجمعيات الأدبية وحلقات المثقفين وغيرها مما يتنوع به المحكي ويغتني. وذلك بدوره يأخذنا في دورة كاملة لنتفحص دلالة العنوان وما يلوح به نحته النحوي كنكرة تتعرف بما يليها، وتفيد من علائق المبتدأ والخبر والمضاف والمضاف إليه التي يتأولها القارئ وهو يتمعن الغلاف بدينامية لوحته الواشية. علاوة على شحذ توقعات القارئ بإحالته إلى نبذة مكثفة لماحة عن الكيفية التي تعمل بها ذاكرة الحوت الصوتية اللاقطة في بيئته الطبيعية، مترافقاً مع الإضاءات الهادية التي تقدمها مختارات عتبات المتن السردي كعدة لازمة تهيئ القارئ، وتجيزه كفاتح لعوالم النص.
ولعل بعض الملامح والسمات والعلامات التي وقفنا عندها في هذه المحاولة للقراءة، تخول لنا أن نختم بأن مساهمة رواية "حفريات ذاكرة الحوت في المدد السردي، لا يمكن اختزالها في ضيق أكليشية عبارة القطرة التي هي بشارة أول الغيث، سيما عندما ينهمر السرد ثجاجاً لينبئ عن الخزين الجمالي الراقد في جوف غمام التضلع الإبداعي الصموت السواي.




 admin
admin