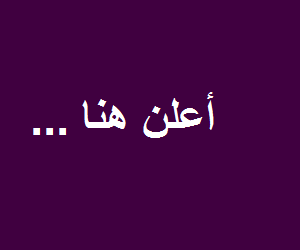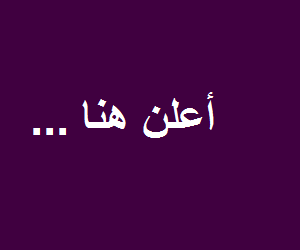رُقية الوجدان
رُقية الوجدان لمياء شمت أقدم لك مفتاح مدينتي ليس من الذهب المفتاح وليس من فضة مفتاحها مفتاح مدينتي من طين خلاصة الخلاصة من طمي النيل ورمل الصحراء .

رُقية الوجدان
لمياء شمت
أقدم لك مفتاح مدينتي
ليس من الذهب المفتاح
وليس من فضة مفتاحها
مفتاح مدينتي من طين
خلاصة الخلاصة
من طمي النيل
ورمل الصحراء ..
أم درمان ليلاه التي لم ينشغل بالتغني لسواها، راحلاً في كل الفجاج وهو يصر وسامتها في قلبه، لتتهمس في كنانة روحه، فيتهدج بها صوته الكهفي الرصين. كيف لا وهي أبداً محجة أفكاره ومركز حسه، فهو وكما البرجل الهندسي يظل يرتكز عندها بساق، فيما يدور بالأخرى ليتمم دائرته الإنسانية والإبداعية الوهاجة المحكمة، كهالة غاصة بالضوء، هي أكليل غاره الأزلي على هامة أم درمان.
هكذا ظل علي المك يعلنها بتعلق طفولي مُحبب ” أنا متحيز جداً لمدينتي". وهل يكتب حقاً إلا مستملياً منها، متطوفاً بأركانها، ومستأنساً بأزقتها الضيقة في “المشوار من محطة مكي لمحطة مكي، مروراً بالزقاق الذي يراه مختلفاً بعين البصيرة والتخيال السخي، "الزقاق لو أشبه نهيراً صغيراً لصب في الشارع الكبير، الذي هو كالبحر حيتانه الناس وامواجه الناس. ذلك الزقاق كل فضله أنه قريب من السوق، لو دخلته أفضى بك إلى السوق، ولو لم تسر فيه صرت أيضاً إلى السوق". ويستمر في مراقبة ذلك الرواق العجيب، الذي هو مسرح (للدافوري) الحار عصراً، وساحة للصوص ليلاً يغريهم بظلامه وتعرجه.
أما عند ضفة النيل فيقف علي المك ليهب اهتمامه الشغوف للسور، الذي كان درع أم درمان الطيني الحصين في وجه من يجرؤ على خوض صفاها. "السور الذي هو عند النيل في الجنوب الشرقي أثر يخلب اللب، حقاً انه ليس في قوة الأهرام، لكنه خالد جداً ويذكرنا بأننا سودانيون".
ويقف المدنف ليطأطئ قلبه حباً لجامع الخليفة، بساحته الوسيعة التي يحلم أن تُشيد عليها مئذنة تطاول السحاب، ويناجيه وحلمه أسير اقبية الواقع "الرمل والتراب فيك ابسطة، والحصى سجادة سخية الألوان من تبريز". ويتجول علي المك هنا وهناك متلمساًً بحسه وحواسه دخائل أم در وجوانياتها. أو كما قال عنه خدنه صلاح أحمد ابراهيم "يتنطس أسرارها واثب العين، منتبه الأذنين يحدث أخبارها".
وتترقرق لمعة في عينيه وهو يناجي أم درمانه الكظيمة، مُدركاً لرهقها وطول اصطبارها، "يخنقها الترك والأنجليز، وبعض أهلها وهي صابرة". ويملأ مسامعه منها وهو يكرع من صوت صبيتها، وهم يستسقون برجاء كبير "يامطيرة صبي لينا في عينينا". ومن إرزام طبول الحوليات، وجوقات الإنشاد بلوحاتها البشرية، وبراياتها الملونة، وشاراتها الخضراء والصفراء والغبشاء. حيث يعتفر هناك علي ترابها جذلاً. حتى أن طعم (الفولية) يجد مكانه محفوظاً بين أفياء تلك الذاكرة الرحبة، الشغوفة برصد أدق ما يقع عليه ذلك الحس الرهيف.
وبفوح مستقطر من عطر الإلفة والمحبة يُعدّن علي في طبقات منجم جمالي عظيم لأم درمانه، بتنقيب عارفٍ يدرك مكامن عروق نفائسها المدخورة، مُتجسدة في أهلها منفتحي السريرة، ناصعي الطوية، والذين لا يجد طمأنينته الأصيلة إلا بينهم، حيث تفيض نصوصه بأسماء وسحنات من يجالسهم ويباسطهم ويمازحهم، أحمد الاسكافي وإبراهيم الفرجة، وسيد أحمد بائع اللبن، وهناك أيضاً عيشة ست الطعمية وغيرها.
وفي وحشة الغربة وبردها الذي يستوطن نخاع العظم وقرار الروح، يستدفئ علي باستحضار تلك الوجوه والقسمات المؤنسة، "وجوه الناس في الغربة تذكرني بوجوه في أم درمان. هذا يشبه فلان الذي في سوق أم درمان". حتى عيون الشحاذ الأجنبي الخضراء الدامعة يرى في خضرتها ورق النيم والجميز ، فيذكي ذلك وجده حتى يجهش: "كم أحبك يا أم درمان يا حاضرة الطين والقش والناس الأكرمين". ويمضي تتسلق أعينه الأبنية الاسمنتية الشاهقة، ذات الكبرياء والصلف، فلا يتردد في أن يفاخرها بأمدرمانه الحبيبة "أنتِ يامدينتي القديمة الشائهة، يا ذات الخيران والزبالة والبعوض.. أحبكِ بكل ما فيكِ من عذاب وألم".
ويفيض وجده حتى ليتمنى أن تتحول مادة انفعالاته تلك إلى تشكيل بصري حاذق، "أريد أن أرسم كرومة، أريد حقاً أن أرسم صوته ورقه الضارب في أوتار القلب". وتتداعى لعلي المعاني وهو يُُحدث بعشق صميم عن خليل فرح "كلماته عسل أمادي، وشربة ماء في تيه الصحراء".
وحين تتمدد بينه وبين أم درمانه الأطوال والأميال، يمضي علي ليشكو غربته، وحاله كحال طعين تلكأ مسعفوه، "إن لهذه البقعة حسناً لاتدركه الأبصار، ولا تعرفه الأنفس أو تحس به إلا حين تفارقها". وهو حقاً لم يطق لها فراقاً فعاد علي المك باراً حفياً كعهده، ليتوسد صدرها، و”ليرقد في حفرة جمعت عاشقين".




 admin
admin