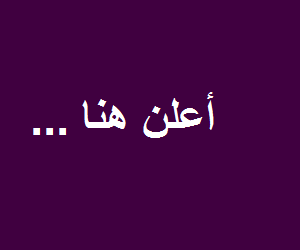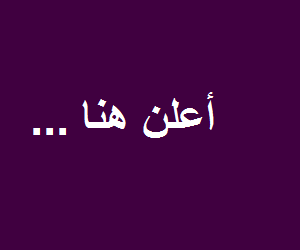تلصص
تلصص لمياء شمت لأجل تسميد حقولها الدلالية والجمالية والتأثيرية، تعول الكثير من الفنون على غريزة التلصص الغائرة في الطبيعة الإنسانية،
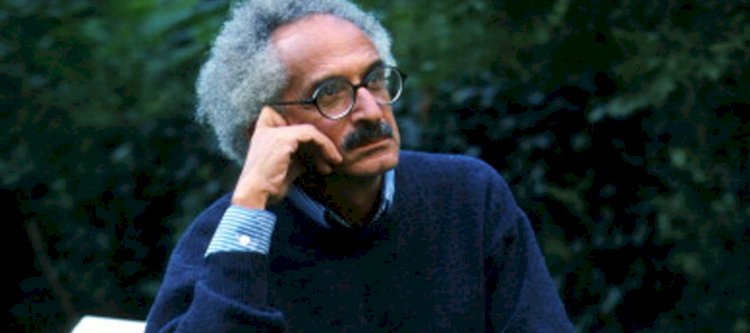
تلصص
لمياء شمت
لأجل تسميد حقولها الدلالية والجمالية والتأثيرية، تعول الكثير من الفنون على غريزة التلصص الغائرة في الطبيعة الإنسانية، كفعل فردي ومجتمعي، غالباً ما يسعى لمراقبة الآخر، ومحاولة الاطلاع على مكتومه، وافتضاض سره، بل وسرقة أجزاء من خصوصيته. ذلك أن استراق السمع والنظر يعد سمة بشرية أصيلة، تنزع لاختراق حيوات الآخرين، والفرجة المختلسة عليها، كنزوع فطري بمحمولات نفسية وفلسفية، يتوق لمزيد من خبرات اكتشاف العالم، واستبار المخفي والمخبوء. وعلى سبيل المثال يقدم فن التشكيل العديد من الأمثلة التي اعتمدت على تلك الاطلالة المتلصصة على فضاء الآخرين. ومن بعض ذلك لوحات تيسو، التي تجيد التلصص على الناس وموجداتهم، وهم في غفلة من عين الرسام الرصادة لكل خلجة وإيماءة.
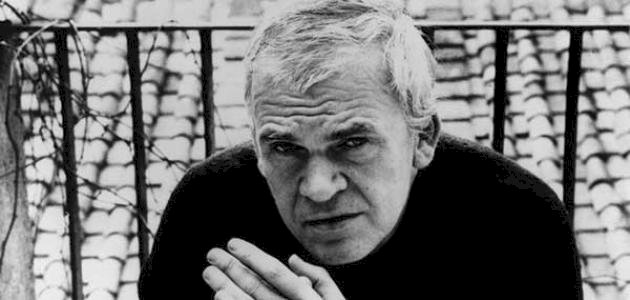
وللتلصص مذاقه الخاص في عوالم السينما، فيكفي أن نتابع استدراج الكاميرا لأعيننا، وهي تجرنا على أطراف أصابعنا إلى زاوية قصية أو ركن خفي، نطل عبره على الخبايا، لندرك أن التلصص تقنية أساسية، وحيلة فنية مركزية، تسخر طواعية عين الكاميرا لاختراق الأسيجة والستور. وعادة ما يتم ذلك عبر استفزازات ذكية، تراهن على فطرية نزعة الفضول لتصعيد ذبذبات التلقي، ورفع درجة التشويق والتوتر.

وإذا ما وصلنا إلى تخوم السرد فإننا نجد أن للتلصص أهميته الواسعة، والتي لا تقتصر على اختلاس النظر لتأثيث سينوغرافية المكان، بل تمتد لتساهم بشكل كبير في تخليق الشخوص، ودفع الأحداث وإنضاج التفاصيل. ولعله ما حدا بيحيي حقي لمحاولة تعريف القصة القصيرة بأنها محض (التحديق من ثقب الباب)، حيث تسقط الأقنعة خلف مستور الأبواب المحكمة الإغلاق. وتكتب مستغانمي في زمان آخر مستكملة لذلك التعريف، بإضافة مزيد من التفاصيل عن مركزية التنصت واستراق النظر، في شحذ قدرة النص السردي على التجاوز وكسر المألوف، حيث تقول: (الروائي سارق بامتياز، غير أنه سارق محترم، لا يمكن لأحد أن يثبت عليه فعل السطو على تفاصيل الحيوات، والخفايا والأحلام السرية).

والأمثلة على ذلك وفيرة ومتنوعة، فقد اكتفى الفرنسي هنري باربوس في روايته "الجحيم" ببطل يراقب الآخرين من ثقب الباب، كنمذجة بارعة للا منتمي، ولإنسان العصر الحديث الموغل في غربته الموحشة.
وهناك أيضاً صنع الله إبراهيم الذي جعل التلصص عنواناً لإحدى رواياته، كيف لا والتلصص يمثل موضوع الرواية وتقنيتها الفنية وثيمتها الرئيسة. فالكاتب يعتمد على عين الطفل الراوي ككاميرا سردية، تتحرك بخفة لرصد تفاصيل اليومي المعاش، عبر مغامرات للتجسس، من خلال النوافذ والثقوب والأبواب المواربة، لا تكاد تنتهي.
ويجد كونديرا أن الروائي (البصاص)، المسترق للسمع والنظر، هو وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها لإخراج الأدب من حيز الإنشائية الوصفية، ليتصل بالحس والحدس والاستشراف، بل ولاستثمار كافة الخبرات والإدراكات، بالعكوف على اللا مرئي في تفاصيل اليومي، وكأداة نافذة لسبر مضمر الحياة، ومحاولة رمي طوق النجاة للإنسان الأعزل، المتورط بلا حيلة في فخ هذا العالم الجامح.

ذات الدافع، ربما، هو الذي جعل ويليام جيمس ينخرط في محاولة ارتياد مستويات ذهنية ونفسية ووجدانية أعمق وأكثر تركيباً، عبر تيار الوعي، لينتقل التركيز السردي من حيز الوصف الخارجي إلى الجوانية، والتوغل في المشكل الوجودي، ببعده الفلسفي. وقد تطورت وفقاً لذلك تقنية المونولوج الداخلي (المناجاة)، والتي وصفها همفري بأنها محاولة لارتياد طبقات الوعي، وصولاً إلى مرحلة ما قبل الكلام، حيث تتكشف دخيلة الشخوص وصراعاتها. وهكذا فلا غرابة إذاً في أن يسهم ذلك مجتمعاً في نحت المقولة الشهيرة بأن الرواية قد عرفت اللاوعي قبل فرويد، وصراع الطبقات قبل ماركس، والبحث عن جوهر الموقف الإنساني قبل الفتوحات الفنومنولجية.
وقد وقف كولن ولسون طويلاً، في تحليله لفن الحكي، عند رواية "كلاريسا هارلو"، والتي كتبها رشاردسن في العام 1748، حيث طبق نجاحها العالم، وأحدثت هزة كبيرة وتأثيراً هائلاً على مجمل التاريخ الثقافي الأوربي. ويخلص ولسون إلى أن ذلك الدوي الكبير يعود ببساطة لطبيعة الرواية التي تدور حول عالم مستتر، نطل عليه من ثقب الباب، حيث يتسلل الراوي على رؤوس أصابعه وهو يومئ للقراء ليلحقوا به، وخطوة بعد خطوة يستمر الراوي في الهمس للقراء وغوايتهم ليتبعونه، حتى تتهدج الصدور وتتقطع الأنفاس من فرط الاستغراق في التلصص والانفعال به.




 myasinplatformltdcom
myasinplatformltdcom