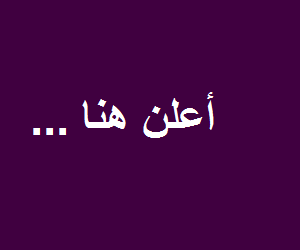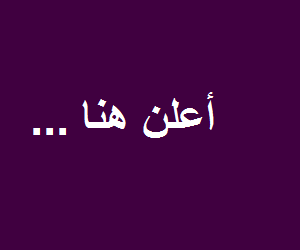بهنس.. هزائم الجيل الثالث (4)
بهنس.. هزائم الجيل الثالث (4) عماد البليك ثمة سؤال يجب التوقف عنده بنزاهة قبل العبور إلى مشروع بهنس الإبداعي، هل تمثيل هذه الشخصية المبدعة لصورة جيل كامل يعني بالدقة التامة أنها تُعبِّر عن كل شيء؟ أم أنها تُحمل محمل الترميز؟

بهنس.. هزائم الجيل الثالث (4)
عماد البليك
ثمة سؤال يجب التوقف عنده بنزاهة قبل العبور إلى مشروع بهنس الإبداعي، هل تمثيل هذه الشخصية المبدعة لصورة جيل كامل يعني بالدقة التامة أنها تُعبِّر عن كل شيء؟ أم أنها تُحمل محمل الترميز؟ وهو المعنى الأدق والأقرب. سوف يكون التقرير الأخير، هو الجواب السليم، لأن بهنس ربما أعيد إنتاجه في المتخيل، وهذه عادة بشرية، إذ أنه إما أن يتأخر الاكتشاف أو أن تطل الصورة من جديد بإيحاءات غير مسبوقة أو غير مرئية أو متخيلة بعد أن يكون كل شيء قد انتهى، وعند التوقف مع سيرة بهنس ورحيله الغريب والحزين في آن واحد، سوف نعثر على كل هذه المجازات والاستشهادات.
إن صورته ككاتب وشاعر وروائي وفنان متعدد المواهب، بالإضافة إلى النهاية المؤلمة ذات الطابع الميلودرامي، كل ذلك يقود إلى إمكانية صناعة نجم متفرد أمامنا ما كنا سنعثر عليه لو أن الرحلة لم تتوقف، وهنا في هذا المنحى العديد من النماذج المبدعة التي يتم تعطيلها وعدم الانتباه لها تمثيلًا أو إعادة تخييل وهي متجسدة حية أمامنا، هذا طابع خاص في واقعنا الثقافي والإبداعي قائم، انعكس في التشريد والاغتراب الذاتي والنهايات السيئة كما قد رأينا في النماذج التي تم العرض لها سابقًا.
هذا ما يسمى بالبحث بعد الضياع وانتهاء الرحلة، وقد تمّ مع أناس كالتيجاني يوسف بشير أو معاوية ونور، وهناك من لم يتم إعادة اكتشافهم إلى اليوم، فعلى سبيل المثال فإن رحلة توليد المداليل الإبداعية في تجربة الشاعر عبد الرحيم أبوذكرى قد توقفت، كما أن إدريس جماع لم يخضع لمعرفة جديدة وغيرهم من النماذج الإبداعية السودانية.

هذا المشروع الحداثي ضروري من النظرة الحديثة والتأويل المفتوح للشخصية والنص مع خطورة ذلك في بعض الأحيان أنه يولد معانٍ غير دقيقة، لكن ذلك ليس مهمًا للعارف، باعتبار أن الإنسان نفسه يصبح تجربة جمالية لا يمكن فصلها عن المشروع الإبداعي، فهما متكاملان، وقد رأينا ذلك في السرديات الإنسانية العظيمة كما في قصص الأنبياء، أو شخصيات كبيكاسو وسيزان والفلاسفة العظماء كأرسطو وابن عربي، كما عملت رواية كـ "موت صغير" على إعادة ابتكاره" حتى لو أنها خرّجته عن الأصالة المعرفية، إذ سنجد أنفسنا في حاجة فعلية لمشاريع من هذا النوع، نحن قاصرون ومقصرون أمامها في مشروعنا الإبداعي السوداني.
على مدار التاريخ كان يتم اختراع أناس بعد موتهم، يعاد انتاجهم ويتم التفكير بهم كأبطال وكمغامرين وكشخصيات "سوبرمانية"، يحدث هذا بدرجة قد يكون فيها شيء من الخلل الرؤيوي مرات، ذلك لأن طبيعة المخيال الإنساني مركبة على صفة الخروج عن الزمن وجدلية المعنى إلى ضده، إلى الوهم والاستيهام، وحيث لا أحد يكون له أن يفهم الحدود المعلنة لبداية الزمن ونهايته وبداية الوهم، وحيث الزمن نفسه ما هو إلا وهمًا عميقًا في درجة من درجاته. تلك كيمياء معقدة لا حدود فاصلة فيها، ليس لها إلا العقل الذي يجرب ويبدع ويناقش ويثابر ليرى الأوجه المتعددة للصورة.

عندما نقرأ تجارب نقدية كبرى عظيمة مثل ميشيل فوكو في "الكلمات والأشياء" سوف نلمح ببساطة هزالة مشروعنا الفكري والفلسفي السوداني، الذي هو غير حاضر بالمعنى الأساسي، إذ أننا بالفعل في حاجة إلى إبداع علم "هرمينوتيكا" سودانية تجعلنا ننظر من جديد إلى المعارف والتقنيات بحيث "تسمح للإشارات أن تتكلم وأن تكتشف معانيها"، لكن أين هذا المشروع؟ إنه لا وجود له ولا يمكن أن يتم بمعزل عن سياق حداثة منقوصة ومشروع انفصامي متشظٍ على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والفكرية.
إن فرادة بهنس بعد إعادة ابتكاره تخييلا، ستضعه في إطار ما يمكن الاصطلاح عليه بـ "البهنسية" التي سوف نُعرّفها بوصفها منهجًا في تفكيك الإبداعية السودانية والهزائم ومجمل العوامل والتبعات التي جعلت الصوت والفعل والرؤية المبدعة المعينة تصل في نهاية الأمر إلى الغياب، لن نقول الفشل، لأن بهنس يظل حيًا والدليل على ذلك ما يكتب هنا في هذا المقال، أيضا إنجاز وتحقق مثل هذا المصطلح الذي يعني بالبحث عن الذات وجمالها خارج سياقات الحياة الممكنة والمتوقعة، أي أننا نكون ونعمل ونكد لأجل المعنى، ولسنا مشغولين بالتقصي بقدر الانشغال بالجمال والفلسفة والروح، إن الحقيقة هنا لن تكون مهمة، لأنها غير قائمة في الأساس في صلب الإبداع، فهي نسبية ومتخفية، في حين الظاهر هو التأويل والقراءة المتجددة.

في الإطار التأويلي ثمة مقاربة جمالية تضع بهنس بمقابل ذلك الإطار الذي صاغه محمد الفيتوري على سبيل المثال، في قصيدة "معزوفة لدرويش متجول"، فبهنس هو ذلك الدرويش، والدروشة هنا هي مزاج صوفي عميق له خاصية الرفض والقبول معًا، هي سيرة الفنان الذي يريد أن يحرك العالم وفق الوعي فينتصر لللاوعي، وفي النهاية يكون عليه أن يواجه الجنون وغيبه الغريب، ليكون له مواجهة قدره الشخصي، في حين يتخلى عنه العالم وينفض الأصدقاء وتبقى له روح خالدة تلتحم مع مجمل المطلق، الذي قد يكون الله، أو الكون برمته، أو الذات الإنسانية، وكلاهما بذات المعنى في التأويلات البعيدة.
إن أفكارًا كالدروشة والنظرة الصوفية وروح الفنان تصبح كلها ذات أداء واحد هنا، يمكن لها أن تصنع التأويلات المفتوحة لهذه الشخصية في بعدها الثاني والجديد، وتخرجها من سياق مادي محدد في مقابل فكرة المتحف التي تقوم على التأطير المحدد للأشياء في تخليد الشخصية، حتى لو أنه يفتح النظر بالتأمل من خلال تصورات الزائر إذا كان استثنائيًا، وهو مشروع سبق أن طرحه أحد معارف بهنس، بأن يجمع أغراضه الشخصية وصوره ورسوماته ومعداته في غرفة.

إن التجربة الإبداعية والجمالية بقدر ما هي شأن شخصي وفرداني يحاط بالمتجليات المادية المحسوسة التي يمكن القبض عليها بعض المرات وقد تضيع، في مقابل المنتج الإبداعي نفسه سواء كان شعرًا أو نثرًا أو لوحة الخ.. إلا أنها سيرة مفتوحة للأزل في المقاربة خارج حدود اللغة نفسها وأدوات الفنان، فالمتجسد لن يكون ما رأه هو بالضبط، كما أن واقع الفنان سوف يصبح صورة ثانية قد يحاط بالغموض أكثر من الرغبة في فك الأسرار، هذا هو طابع أي معرفة باحثة عن الحقيقة، لأنها في نهاية الأمر كما في رواية "مسرة" للسوداني بشرى هباني (1989) تظل ذات أوجه عديدة وتتشكل حسب الفضاءات التي نرغب في رؤيتها أو تمثلها، وتبقى رحلة بحثنا عنها ليست إلا الطريق الذي يشكل متعة الاستقصاء وتبني كفاح الذات لأجل إنجاز النص الجديد، حيث يضيق الطريق كلما تشعبت المعاني؛ ضيق الرؤية باتساع العبارة.




 myasinplatformltdcom
myasinplatformltdcom