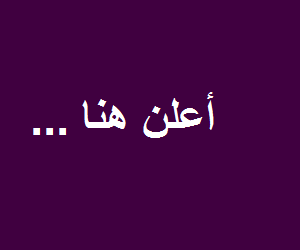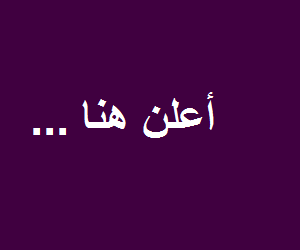في وداع الســودان
في وداع الســودان باسـم فرات وأخيرًا، انتهت تجربة فريدة في حياتي، تجربة بدأت في الخامس من شهر آب "أغسطس" عام 2014 ميلادية، وخَتمتها بالرغم مني في يوم الثلاثاء المصادف التاسع من شهر حزيران "يونيو" سنة 2020 ميلادية، وهي سنة وباء الكورونا بامتياز

في وداع الســودان
باسـم فرات
وأخيرًا، انتهت تجربة فريدة في حياتي، تجربة بدأت في الخامس من شهر آب "أغسطس" عام 2014 ميلادية، وخَتمتها بالرغم مني في يوم الثلاثاء المصادف التاسع من شهر حزيران "يونيو" سنة 2020 ميلادية، وهي سنة وباء الكورونا بامتياز، هذا الوباء كان سببًا رئيسًا وأوحدًا في مغادرتي للسودان. كان إجلاءً، بل اقتلاعًا، وكل اقتلاع هو نفي، حتى لو كان الاقتلاع مؤداه العودة إلى الوطن، ترك المكان مُكرهًا سيجعل من المكان جنة مفقودة حتى لو كان المكان خَربَةً، حتى أنني أحنّ إلى الغبار الذي يملأ الشوارع، أحنّ إلى بائعات الشاي والقهوة، المناضلات الحقيقيات اللواتي يملأن الساحات والأرصفة كَدحًا من أجل لقمة عيش بكرامة في بلد يُعدّ سلة الغذاء العربي.

كانت رحلة المغادرة صعبة ومُتعبة، مررتُ فيها بأدوار من القلق والحزن والترقّب والخوف والرغبة العارمة بمعانقة الحياة، وكلي أمل أن أعود إلى الخرطوم حين ينتهي هذا الوباء، أعود إلى شقتي في المعمورة (أحد أحياء جنوب الخرطوم السكنية)، إلى كُتبي ومكتبتي التي تزدهي بكتب كثيرة عن العراق والسودان وعُمان، فضلًا عن كتب الأدب والشعر بخاصة. شقتي التي أَلفتها حتى أصبحت مأواي وحاضنتي، عُشي الواسع ووطني الصغير، ستة أعوام نمت علاقة دافئة مع المكان، ومن حُسن الحظ كانت شُرفة الشُّقَّة أكبر شُرفات العمارة، وكم تمنيت أن أجعلها حديقة غَنّاء، ولكن ارتفاع درجات الحرارة على امتداد العام تقريبًا وكثرة أسفاري حالت دون تحقيق هذه الرغبة، لكني عوضتها بحديقة العمارة التي كنتُ أعتني بها مثلما كان يعتني بها حارس العمارة الأخ والصديق "الباقر" الشغوف بالحديقة والنباتات.

كنت كل صباح حين أنهض من السرير، أذهب مباشرة إلى غرفة المكتب ومن الشباك أطل على الحديقة وأتأملها، أشعر بالراحة فعلًا، ثم أباشر يومي الذي يبدأ بالاستحمام وشرب أربع كؤوس من الماء ثم المشي وعادة ما يكون فوق سطح العمارة، ثم تناول الفواكه ثم الفطور الذي يتكون من الشوفان واللبن "الزَّبادي" وهو أحد أَلَذّ الألبان "الزَّبادي" التي تذوقتها في العالم، إنه لبن "زبادي" "كابو" الذي تنتجه "مجموعة دال" وهي المالكة للمدرسة أيضًا.

عقدت علاقة محبة مع أرض النيلين، وفي أول وصولي، تواصل معي الصديق "طارق رحيم" ودعاني إلى جلسة على نهر النيل ثم جولة نيلية مذهلة، وقال جملة أثبتت الأيام صدقها ودقتها وأنه لم يقلها بواعز عاطفي جَيّاش تجاه وطنه وأهله، جملة سأبقى أكررها، ألا وهي: "أجمل ما في السودان أهله"، نعم صدقًا وحقًّا، أجمل وأطيب ما في أرض النيلين أهلها؛ وبدأت أتلمس طريقي إلى قراءة المجتمع السوداني بعين الشاعر والباحث الذي عركته البلدان والمجتمعات والرحلات والتجارب والقراءات، وكانت كفة الخير والجمال والمحبة تميل دائمًا إلى جانب هذا البلد وأهله.
قمت برحلات استكشافية للخرطوم ومحيطها، وفي إحدى المرات وصلت إلى نهر النيل الأبيض، وكنت قد ابتعدت عن الخرطوم، على أطراف ضواحيها، أخذ مني العطش مأخذًا، ولم أجد مَن يبيع الماء، وفي الطريق شاهدت شابـًّا يبيع الفواكه، دكانه في العراء، يحمي نفسه وفواكهه من حرارة الشمس بأقمشة تحنو عليه، وما أن عرف أنني عراقي حتى امتلأت أساريره حبورًا، وأخبرني أن لقبه "بغدادي" وأن جذورهم البعيدة من بغداد، وسألني كيف بغداد؟ وفي الأخير قال سيروا "طَوّالي" أي إلى الأمام مع الطريق العام وهناك ستجدون حانوتًا، ما أن وصلنا حتى نزلت من السيارة مسرعًا ولشدة العطش اشتريت عدة قناني ماء.

رويدًا رويدًا، بدأت الخرطوم تغريني، مدينة بين نهرين، وبدأت أتلمس خصوصيتها، أنا الذي تعلمت أن لا أقارن بين المدن واللغات والثقافات، مقارنة تؤدي إلى تكريس نموذج ما، إذ لا وجود للنموذج، فلكل بلد ومدينة وثقافة ولغة وعقيدة خصوصيتها؛ لو آمنّا بهذه الحقيقة أو الرؤية، لما كَرّسنا العنصرية والاستعلاء والإلغاء والإقصاء، فحين تعتقد أن لغة ما هي لغة العلم والآداب والفنون والحضارة والمدنية والـرُّقيّ، فأنت تُكرّس الإلغاء للّغات الأخرى كافة، واستعلاء هذه اللغة ومَن يتحدثها ويجيدها، على بقية اللغات والناطقين بها وتراثها، ومنجزاتها، إذ لا فرق بين اللغة التي تتوهم بأنها اللغة الأهم أو لغة الحضارة والعلم والثقافة وبين أية لغة أخرى مهما كان عدد الناطقين بها ومهما كان منجزها، فاللغات مثل الفنون الشعبية، فكل الفنون الشعبية في العالم في أوربا وفي أعماق إفريقية وغابات الأمازون وأعالي جبال الأنديز وجبال الهمالايا وجبال وغابات جنوب شرق آسيا، تتمتع بمستوى واحد وبالأهمية نفسها.
أول شارع في الخرطوم سحرني هو شارع النيل، بأشجاره العملاقة"أشجار المهوقني"، هذا الشارع الذي يمتد ما بين جسر المنشية محاذيًا نهر النيل الأزرق حتى جسر الـمُقرن، تخاصره جامعة الخرطوم ولكن من بواباتها الخلفية، كنت وأنا في السيارة، أنتشي تأملًا وأتيه انجذابًا في هذا الشارع الذي تصطف وزارات وبنايات مهمة فضلًا عن القصر الجمهوري بحدائقه الواسعة وما خلّفه من مرارات في جسد الشعب السوداني، وكذلك قاعة الصداقة التي حضرت عددًا كبيرًا من فعالياتها أشهرها جائزة الطيب صالح العالمية، وحفلة عازف العود نصير شمة الذي حملني إلى بغداد بريشة عوده، فسبحت في نهر دجلة ودخلت ألف ليلة وليلة، مصفّقًا لشهرزاد كلما ملأت عَينَي شهريار بالنعاس.

شارع النيل، الذي قبل أن يقفل أبوابه ويُسلّم مفاتيح صخبه لجسر المقرن، يشمخ على جبينه روح السودان، إنه المتحف القومي، الذي زرته مرارًا وتكرارًا بلا ملل، هذا المتحف الذي لم يلمس عناية كبيرة من القائمين على شأن البلاد، وكنت كلما أزوره أسأل نفسي: هل هناك علاقة طردية بين فساد الأنظمة وبين تدهور صناعة المتاحف والمكتبات؟ أليس المفروض أن المتحف السوداني يكون أكبر وأوسع ويشمل مكتبة ضخمة وقاعات وإلى آخر ما تتطلبه صناعة المتاحف والعناية بواجهة البلاد وروحها؟ المتاحف روح البلاد.
كنت و"جينيت" (هي التي تقود السيارة) في أغلب أيام الجمع نَمرّ بالسيارة قاطعين شارع النيل متوجهين إلى أم درمان، لزيارة أسرة الصديقة "خالدة ياسين" أصبحت بمثابة أسرتنا في السودان، ونتناول الغداء معهم بحسب التوقيت السوداني، وكانوا ينتظروننا لو تأخرنا، ويجبروننا على تناول الغداء مهما قدمنا من الأعذار، إنه كرم السودانيّ، ومتعته الكبيرة بتقديم كل ما يملك من حفاوة بالضيف؛ وفي طريق الذهاب من حي "المعمورة" في جنوب الخرطوم إلى حَيّ المهندسين (حَيّ سَكَنيّ في وسط أم درمان)، كنت أتأمل نهر النيل الأزرق وجزيرة "توتي" هذه الجزيرة الساحرة التي تقع زاويتها الجنوبية عند ملتقي نهري النيلين الأزرق والأبيض لتكوين نهر النيل، وتتوسط المدن الثلاث المكونة للخرطوم الكبرى وهي الخرطوم وأم درمان وبحري، وهذه الجزيرة زرتها مرارًا لما تمتاز به من عدد كبير من الطيور وبيئة ريفية ومن حُسن حظها أن تربتها لا تتحمل العمارات الشاهقة وإلّا أصبحت عبارة عن خرسانة حديدية.
بدأت الشوارع تدخل ذاكرتي، والألفة حقول تفترش منفاي، أنا قارئ الأمكنة، أتهجى أنوثة الأشياء بدقة مندائيّ يعكف طوال وقته على صياغة جواهره النادرة، ودهشة طفل في الوقت نفسه، إذا كان لكل بلاد نباتها الخاص فنبات السودان المحبة، أينما تمضي تقطف محبة، حتى خلتُ لو أن أهل السودان نشروا محبتهم على كوكبنا لتوارت الكراهية بعيدًا؛ وفي أيام تلمسي لأعماق المجتمع السوداني، قابلت رجلًا أكمل الستين من عمره منذ سنوات عديدة، ولا أظن ثمة سنوات بينه وبين عامه السبعين، جاء أبوه من سـوريّة، في ثلاثينيات القَرن العشرين، وعاش في غرب السودان في المناطق الملتهبة بالعنف والحروب.
حدثني أولًا عن أبيه وعمه اللذين غادرا سورية إلى مصر وعملا معًا ثم اختلفا فجاء والده إلى هذه البلاد، ثم تحدث عن طيبة السودانيين المفرطة، وكان يتحدث والألم يعتصر قلبه وهو غير مُصدّق أن الذين يمطرون طيبة يستخدمون العنف، وكان في كل جملة يؤكد أن طَرفَي النزاع يملكان طيبة واحدة وبمقدار واحد أنها طيبة السودان التي لا تُبارى، وكان يأسف لما حدث ويحدث من عنف، ويؤكد أن هؤلاء الناس لو تُركوا بلا تدخلات مغرضة وخبيثة لعاد الوئام يجمعهم، ثم تنهد تنهيدة عالية مسموعة، ولم يكن باستطاعته أن يُفصح بسبب سيطرة نظام البشير وما بثه من خوف، وهو الرجل الذي دفع للأيام جزءًا من رجله.
الانتقال من مكان إلى آخر ليس بالأمر الهيّن، لكن شخصًا مثلي أصبح اللا استقرار استقراره، وكل الأمكنة مَنافيه الأثيرة، شخصًا حين أيقن أن زمن المنفى طويل، وأن حياته منفى لا قرار له، تصالح مع الأمكنة، وتعلم لغة "المنفي الأبدي" التي تعني حين الانتقال إلى مكان جديد، يبدأ العمل بجدٍّ لزراعة ذكريات، وتهيئة الحاضر ليكون ماضيًا مليئًا وثريًّا بالاكتشاف والدهشة واقتفاء أثر الجمال أينما كان، هكذا عملت في السودان، فحصدتُ كنزًا من الذكريات الجميلة، كنزًا من محبة السودانيين، ومثلما يفيض النيل سنويًّا، فيعمّ الخير مناطق شاسعة تمتد حتى سواحل البحر المتوسط، كذلك إقامتي في الخرطوم فاضت انتاجًا كتابيًّا غزيرًا.
وإذا كنت أعدّ هيروشيما مرحلة الطفرة الإبداعية في مسيرتي الشعرية، فإن الخرطوم الطفرة الإبداعية في أدب الرحلات، وتطور كتاباتي الأخرى في المقال ومفاهيم الهوية ومصطلحات مثل "القومية والإثنية" و "الكتابة والتدوين" والذاكرة الجمعية المكانية" ودورها البالغ في تفكيك سرديات تضخيم الأنا واحتقار الآخر أو تجريمه؛ فقد أنجزت أربعة كتب كاملة في أدب الرحلات، هي الثاني والثالث والرابع والخامس، أما كتابي السادس "طريق الآلهة .. من منائر بابل إلى هيروشيما" فقد أنجزت في الخرطوم أكثر من ثماني وثلاثين ألف كلمة من مجموع خمس وأربعين ألف كلمة إلّا قليلًا، فضلًا عن عشرات الصفحات من كُتب قيد الكتابة عن السودان وعُمان ومناطق مختلفة حول العالم زرتها.
إذا كان "عباس الشيخ" أول سوداني خارج السودان ألتقيه وأرتبط بذكريات عميقة معه، وأكرمني بترجمة عديد قصائدي للغة الإنجليزية، وبفضل ترجماته أصدرتُ أكثر من كتاب شعري بالإنجليزية، فإنني في السودان تعرفت على عشرات الشعراء والأدباء والمثقفين السودانيين، ووبعضهم ترك أثرًا طيبًا يستحق أن أذكره ردًّا لجميله ومعروفه وكرمه، وإن كنت لا أفي بعضهم حقّه مهما أثنيت وشكرت، ولأن من الصعوبة ذكر أسمائهم بحسب منازلهم في المحبة والكرم والمواقف النبيلة والحفاوة بي يُعدّ ضربًا من المستحيل، فسوف أذكر سبعة أشخاص لما للرقم سبعة من رمزية عالية، وعذرًا لمن لم استطع ذكر أسمائهم هنا.
أكثر امرأة لم تخفت حفاوتها بنا على امتداد ستة أعوام، هي السيدة "خالدة ياسين" التي ذكرتها أعلاه، وهذه المرأة مع بناتها، قضينا عشرات الـجُمَع في بيتها في "أم درمان" فضلًا عن مرات عديدة دعتنا على عشاء في مطاعم الخرطوم، كانت أختًا وصديقة ورفيقة وكانت تتصرف معنا بالروح السودانية التي ذكرتها مرارًا في كتاباتي وأحاديثي وملخصها أن الشخص غير السوداني، يُعامله أهل السودان النجباء بوصفه ضيفًا والضيف في العُرف العربي – الإسلامي هو "ضيف الرحمن"، حتى أنني ذكرتُ مرة في أمسية شعرية لي في مبنى اتحاد أدباء وكُتّاب النجف: "مَن يريد أن يعيش مدللًا في حياته فليذهب ويُقِمْ في السودان"، وهذا ما لمسته من السيدة خالدة ياسين وبناتها ومن عشرات السودانيين.
الشاعر "الأصمعي باشري" من أوائل مَن احتفوا بي، وحين قررنا زيارة "الشلال السادس" والمعروف عند السودانيين ب"السَّبَلوقة" وأهرام البجراوية، اقترح أن نذهب معًا، لنبيت في بيتهم وكانت فرصة ثمينة أن زرنا هذه الأماكن وتجولنا في مدينة "شَندي"، فكان خير عون لنا، وتكررت لقاءاتنا، وأقام لي أمسية في اتحاد كُتّاب السودان بالتعاون مع "منتدى مشافهة النص"، الأصمعي باشري شاعر جيد وصديق كريم ويحمل صفة عراقية خالصة وهي أنه سريع الاشتعال سريع الابتسام، فهو ينزعج و "يُعَصّب" لأبسط الأسباب، ولكنه سرعان ما يبتسم أمام أي كلمة طيبة. أتذكر في بداية وصولي للسودان، حدث خلاف إيراني – سوداني، وراح وعّاظ السلاطين يلعنون ويشتمون الشيعة ويُشككون بإسلامهم، ومرة كنا معًا في إحدى الحافلات، وسمع واعظًا سلفيًّا متطرفًا في عدائه للشيعة، يخطب في الناس بكراهية، فلم يكن من الأصمعي ونحن في واسطة نقل عامة، إلّا عبر عن رفضه واستنكاره بل مثل أي عراقي راح يكيل الشتائم له، وأكاد أزعم أن الأصمعي هو السوداني الوحيد الذي رأيته تَسخن أعصابه لأبسط الأمور، ولكنه يحمل قلب طفل برئ وهو صديق صدوق.
الشاعر والأديب "عادل سعد يوسف"،مبدع حقيقي وصادق ونقي، جمع بين موهبة الإبداع ودماثة الخلق والكرم، لا يتوانى حين أسأله أو أحتاجه في أمر ما، وأقول لا يتوانى وليس لم يتوان، لإيماني أنه سيبقى باسطًا يده لي وأنا في مشرق الأرض وجنوب الجنوب، فلا أحسبه يتوانى في يوم ما لو سألته مساعدة أو معلومة أو وجهة نظر أو رأيًا في أمر من أموري، هذا الشاعر المثابر، هو كاتب مسرحي وروائي أيضًا.
القاص وكاتب أدب الرحلات والمترجم عثمان أحمد حسن، نموذج حقيقي للسوداني على فطرته الأولى، فيه السماحة بادية، والكريم هو مَن إذا قدمتَ له كأس ماء أثنى على كرمك على الملأ وكأنك قدمت له مائدة طعام يتحسر أمامها الملوك والأمراء، حين سمعته أول مرة في حديقة الشهداء وهو يقص علينا رحلاته، ولاحظت دقته والتفاصيل والمقارنات التي يذكرها، ألححت عليه أن يجمع ما كتب في كتاب ويشترك في جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات، وتابعته حتى فعل واشترك، وأن سعادتي لكبيرة حين فاز، شعرت وكأنني فزت. عثمان أحمد حسن سوف لن يغادر ذاكرتي.
الشاعر والناشر إلياس فتح الرحمن، أول لقاء به حين قرأنا معًا في أمسية في اتحاد الكُتّاب في الذكرى السادسة لرحيل الشاعر محمود درويش، وقد أهداني قصيدة، وقرأ قصيدة هجائية غاية في الجرأة في هجاء الرئيس الأسبق عمر البشير، ولأني مهما طال الزمن سأبقى أشعر بالرعب فقد استوطن الرعب أعماقي بما عشته في العراق قبل خروجي، فقد انتابني الرعب، وأخبرته لاحقًا بذلك، وكان يُعتقل ويطلق سراحه ويعتقل مرة أخرى وهكذا، ولن أنسى موقفه معي حين تعرضت زوجتي لفقد عملها تعسفيًّا من قبل المدير السابق لمدرسة مجتمع الخرطوم المدعو "نايجل" فقد سعى لإجبار المدير على الرجوع عن قراره عبر مالكة المدرسة السيدة سامية. وبفضل هذا الموقف أقمنا ثلاثة أعوام أخرى في الخرطوم ولولا جائحة كورونا كوفيد 19، لكنا الآن في الخرطوم.
صلاح عوض النعمان، قاص وناقد، من خريجي العراق، يحمل حبًّا جمًّا للعراق، يشعرني بأنه يتمتع بتقديم أية مساعدة لي، ويردد دائمًا: فضل العراق والعراقيين كبير في عنقي وأتمنى أن أقدم ما أستطيعه لك"، يحمل روحًا ديمقراطية وينصت للمختلف جيدًا، ذهبت معه لميدان الثورة، وعرفني بقيادية في الحزب الشيوعي السوداني امرأة ذات شخصية قوية للغاية عانت كثيرًا من نظام عمر البشير، كانت زيارتي لميدان الثورة زاخرة بالثراء بفضله فهو لا يكف عن الشرح والتوضيح وتعريفي بشباب وبقياديين. وحين غادرت الخرطوم اضطرارًا سألته أن يضع ما تركته من "عفش" في حقائب وصناديق ورق مقوى، فكان يفتح كاميرا الهاتف ويريني قطعة قطعة فإن أخبرته أحتاجها يضعها في الحقيبة أو الصندوق وإلّا فيضعها في مكان آخر، أذهلني وزوجتي بدقته وحرصه والوقت الذي قضاه وعناء النقل أمام غلاء المعيشة والعملة السودانية المتدهورة.
أصدقائي السودانيون لقد تركت حدائق ياسمين وورد وقداح وفل في قلبي بمحبتكم وكرمكم ونبلكم، ممتن لكم فأنتم جمعتم بين الإبداع والإنسانية بأرفع صورها، ذكرت هؤلاء وهناك مجموعة أخرى مثل الصحفي محمد مبروك الذي كان أخًا كبيرًا بمحبته ولطفه ونبله والأديب نادر السماني والمترجم صلاح محمد الحسن والشاعر والصحفي محمد نجيب محمد علي والشاعر والصحفي حاتم الكناني والشاعرة إيماض بدوي والرسام حسين ميرغني والشاعر والفنان ياسر عوض والشاعر والفنان ياسر فائز وآخرين لهم جميعًا محبة لن تمحوها الأيام.
حين وصلت إلى هنا (زي الجديدة) شعرت بحزن كبير، كأني فقدت السودان، خروجي من السودان كان اقتلاعًا وأستطيع القول إن ثلاثة أماكن أحزنني كثيرًا فراقها وطني العراق، وهيروشيما والخرطوم، الشعور بالاقتلاع موجع للغاية، وحنيني الكبير للخرطوم هو الوفاء الذي أستطيع أن أقدمه للسودان وللخرطوم ولأصدقائي هناك، راجيًا أن تسمح الظروف بزيارات عديدة ومستمرة إلى أرض النيلين والطيبة والسماحة والكبرياء، أرض الكنداكات الجميلات الجريئات الأبيات.




 myasinplatformltdcom
myasinplatformltdcom