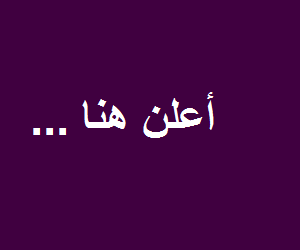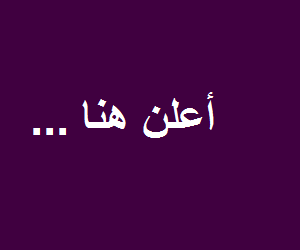مفهوم ما بعد العلمانية
مفهوم ما بعد العلمانية د. بكري خليل يبدو أن المتغيرات العالمية قد زحفت على سائر المفاهيم الفردية منها والعامة التي تشكلت في العصر الحديث لتشمل أيضاً ثنائية الوعي الديني والوعي العلماني التي بدت وكأنها حالة حدية وعصية على الحل أو التأليف والتقريب بين طرفيها.

مفهوم ما بعد العلمانية
د. بكري خليل
يبدو أن المتغيرات العالمية قد زحفت على سائر المفاهيم الفردية منها والعامة التي تشكلت في العصر الحديث لتشمل أيضاً ثنائية الوعي الديني والوعي العلماني التي بدت وكأنها حالة حدية وعصية على الحل أو التأليف والتقريب بين طرفيها.
فبعد انطواء صفحة الحروب الدينية الأوروبية في القرن السابع عشر، توطدت الدولة القومية، وأصبح القرنان السابع عشر، والثامن عشر الميلادي عصرين للعقل والتنوير حملا الإنجاز العلمي والثورة الصناعية على جناحيهما ومهدا لعصر الاستعمار وإقامة نظامه على امتداد العالم.
وشهدت القرون اللاحقة تفكيكاً منظماً للدين في الغرب، انتهى بإقصاء ذلك الركن الهام في التاريخ عن موقعة في البيئة الاجتماعية وعن حضوره الثقافي. ونجحت محاولات عزل الدين عن الحياة العامة حتى ظن البعض أن زمان الدين قد ولى، ومن بين هؤلاء رجال دين يهود ومسيحيين سلموا بأن العلمانية قد انتصرت نهائياً على الدافع الديني.
غير أن هذه الأجواء كانت تبطئ عناصر الحراك الديني الذي أخذ ينمو بوتائر متواضعة داخل العالم الغربي أو خارجه خاصة في العالم الإسلامي وفي الكثير من المنظومات الدينية، أما بسبب تراجع التجارب الوطنية وما رافقه من احباطات أو لتمدد أنماط الحداثة بشكلياتها وآثارها الاجتماعية وتخلخل الأوضاع التضامنية الاجتماعية وتبعاته السالبة.
وتمخضت هذه التطورات عن هزات عميقة زعزعت الكيانات الاجتماعية والبني الثقافية السائدة، فتآكل جزء مهم من رصيد المجتمع التقليدي ومكتسبات مرحلة التحرر الوطني المبكرة، الأمر الذي أطلق أشواقاً روحية غائرة في النفوس.
وفي هذه الأوضاع المضطربة، توالت الأصوليات الدينية والاثنية الكامنة كردات فعل لمرحلة التحديث الأولى التي شددت على تبني قيم عصر العلم والإيمان بالتقدم المادي، مروراً بمرحلة التحديث الثانية والعولمة التي هيمنت عليها النزعة الاستهلاكية حتى أصبحت هدفاً وغاية قصوى دون منازع.
فمع الموجة العولمية جرت متغيرات نوعية شملت الموضوعات التي تصدرت قضايا مرحلة التحرر الوطني في العالم الثالث وكذا مفاهيم الحداثة والاهتمامات السائدة في أعقاب الثورة الصناعية في الغرب، فانتقلت مشكلات البيئة والمعلوماتية والهندسة الوراثية والجنسانية وأمراض نقص المناعة وغيرها إلى الواجهة، وهي أمور تؤشر انعطافاً من الايديولوجيا إلى إشكالات المصير الإنساني والنظام القيمي والاجتماعي والمجال الثقافي والمعرفي.
وانبعثت بالترافق مع هذه المعطيات موجات دينية تشدد على العودة إلى المنابع الروحية في مختلف الديانات بلغت أوجها في بروز تيارات احتجاجية وعنيفة في معظم الديانات، وأخذ الإقبال على ممارسة الشعائر يجري بدرجة واسعة، وازدادت حركة التوعية الدينية إلى جانب انتشار ديانات جديدة في عمق المجتمعات الغربية اصبحت لها إتباعها ومناصيرها.
ومرة أخرى واجهت مقولة تخطي العقل للإيمان موقفاً عملياً مضاداً بعد أن ظلت موجات الحداثة تطرق بشدة على مبدأ الذاتية التي تجعل الإنسان معياراً أوحداً لا حاجة له بأية ضمانة خارجية، فأصبح الفرد أساس نظام العالم.
وجاءت العلمانية محمولة على ظهر ذلك المد و تكاملت في القرن التاسع عشر مكرسة هذه المعاني إذ دفعت بمطابقة الذاتية للحرية نحو شوطها الأخير والنهائي عندما اعتبرت أن مسلمتها الجوهرية هي حق الإنسان في التفكير واكتفائه بذاته، فيما ذهبت بالمقابل الى تاكيدها على حرية العبادة وممارسة الدين وفي نفس الوقت التحرر من الدين وحياد الدولة في قضايا العقيدة والإيمان.
وبموجب العلمانية ينبغي إقامة كافة نشاطات الإنسان وبناء قراراته على الدليل والحقائق المادية وليس على المعتقدات الخرافية والأسطورية، وأن لا تكون السياسة تحت سيطرة الدين وأن تبقى حرة من قيوده.
لذا فإن ما طرحة تيار العلمانية الأصولي في حق الإنسان في التفكير بذاته أي حرية الفكر وحق الاختلاف، والذي أصبح وكأنه قد خلّف وراءه كل مرجعية تتجاوز العقل، قد بات في موضع المراجعة.
وأصبح العقل الذي كان الأساس الموجه للمبادئ المدنية والنظم الدستورية خاضعاً لنقد يتجاوز مقولات التنوير وأسس العلمانية التقليدية بحسبان أن العقل قوة منتجة للمفاهيم والعلم والتقدم، ولكنه أيضاً قوة تحمل باليد الأخرى أدوات التدمير والإبادة وتعويق ازدهار البشرية والقضاء على ثمار إبداعها.
كما انطوت العلمانية على تناقض ذاتي يتمثل في أنها تدعو إلى معيارية الفرد بينما أصبحت هي ذاتها معياراً موضوعياً يستند إلى قيم عامة ومبادئ كلية لابد من أن تكون مرجعية في المطاف الأخير.
وأثارت هذه المسائل مسائل العلمانوية المنغلقة المتعصبة و المناهضة للدين من مواقع النقد والمساءلة وبحسبان أن العلمنة مفهوم تاريخي ولا ينبغي لها أن تتمترس خلف يقينيات مطلقة تحيلها الى معتقد دوغمائي ايضاً.
وفي هذا الإطار طرح فكر ما بعد الحداثة قضايا التعددية في مقابل واحدية البديل الثيوقراطي أو العلماني الليبرالي وأهمية الإفادة من كليهما كرؤى متشربة بالحقيقة وبالتالي تبادل عناصر بناء الموقف المشترك بينهما وإقامة أرضية تفاهمية.
وهنا كان نشوء الاتجاه ما بعد العلماني نابعاً من أسباب عديدة في المقدمة منها وجود عناصر علمانية في الفكر الديني ووجود نفحات لاهوتية في العلمانية. لذا أصبح الانفتاح المتبادل أمراً مطروحاً ينصرف إلى وضع الفرضية الأساسية للحداثة القائلة بأن العلمانية سوف تسود كل أوجه السلوك الاجتماعي والفردي في موضع المساءلة.
وكما يشير محمد أركون فإن العلمنة قد اخترعت ككلمة داخل سياق الصراعات الهائجة التي جرت بين الكنيسة والدولة في فرنسا، والفكر الإنساني الحديث يطالب بالمراجعات واختراق الحدود والحواجز الموروثة عن الماضي الذي هيمنت عليه التأويلات الايديولوجية للأديان وإحلال الأديان العلمانية محل الأديان التقليدية.
وعبر هكذا تصورات، أصبح للثقافة والقيم ترابطها ضمن الأفق النقدي الذي يرفض تحول العلمانية إلى فكر لاهوتي وثوقي يقدس مقولاته، ويرى بالمقابل أن الوعي الديني ينبغي أن لا يتجمد في مسلمات تأبى أن تنفتح على الحياة ومتطلبات التجدد.
ففي حين تمثل العودة للدين في العالم الإسلامي في شعار "لإسلام هو الحل" الذي دعا إلى تطبيق الشريعة وتقنينها وإقامة الدولة على قواعدها، فإن ما بعد العلمانية في الغرب يدعو إلى تأسيس منظور لاهوتي للحياة كمحاولة لتجاوز حالة التناقض بين ما هو علماني وما هو ديني على أساس أن كل منهما في حاجة إلى الآخر.
ويرى بعض الكتاب أن ذلك هو من قبيل تشذيب الدعوات الدينية لتدعيم ما هو دنيوي وفي الوقت نفسه الوقوف بوجه الموانع التي طالما وقفت في طريق الإيمان بالله والحياة الأخرى وغيرها من المعتقدات الدينية.
فالنظام العلماني المتماسك والمتشدد قد آثار الإحساس باللا معنى وأدى إلى شعور بفراغ حقيقي في الحياة الثقافية والسياسية وكان سبباً في ظواهر التمرد والعنف، وبدأ أن المجتمع يدفع ثمن تلك الحرية التي لا تعرف حدودا وتجيز كل ما يريد الإنسان أن يفعله حتى أصبح الشك يلف مصير العلمانية.
ويشير "باتريك جلين" في كتابه "مدخل لمجتمع ما بعد العلمانية" أن هناك نواقص في الأسس الفكرية للعلمانية في نظرتها للعالم، وبوحي من التقاليد الديمقراطية والتي تعني العقلانية والتسامح والاحترام المتبادل، فإنه يؤكد على وجود جوانب دافعة للتوليف بين التفكير ما بعد الحداثي والوعي الروحي، ومن هنا يأتي اهتمامه بإنجاز إحياء ديني في البني العلمانية الأمريكية.
ومع إقراره بمشروعية المجال العلماني إلا أنه ينحو إلى تأسيس ديمقراطية روحية والربط بين المفاهيم الدينية العامة مثل الله وأصل الكون لكي يجعل منها بؤرة أو معقداً للعواطف الروحية الجماعية.
فمنذ بضع سنين يقوم العديد من الفلاسفة والمفكرين الغربيين المعاصرين بالبحث في العلاقة بين الدين والعلمانية، بل أن ذلك تحول إلى نوع من التأصيل بربط قيم الحداثة والعلمانية بالتراث المسيحي واستيحاء بعض التطورات التاريخية منه كما فعل من قبل "ماكس فيبر" عالم الاجتماع الألماني عندما أعاد نشأة الرأسمالية الحديثة إلى أصول كالفينيه وتوصل إلى أن العقلانية المتزهدة في أوائل العصر الرأسمالي ذات جذور في الروح الكالفينية البروتستانتية.
فها هو "جاك دريدا" الفيلسوف الفرنسي ورائد التفكيكية قد رفض الرؤية الكونية الضحلة لحركة التنوير الأوروبي والتي لم تفشل في هدم الدين فحسب، وإنما وضعت مقدمات ردة الفعل الأصولية الحالية.
ويقول "دريدا" إن هناك مساحة للتأمل فيما هو ديني بمعزل عن المظهر التاريخي للدين، وخارج المقدس والدنيوي. وفي هذا المجال يمكن الجمع بين العقل والإيمان وتكوين ثقافة كونية قائمة على الاعتقاد، والمجال المشار إليه هو سابق في الحقيقة على الصراع التاريخي بين العقل والإيمان.
أما "يورغن هابرماس" الفيلسوف الألماني البارز فقد ضمن كتابه عن الفعل التواصلي، رأيه في أن أفكار العدل والمساواة قد استنبطتها العلمانية عن التعاليم والوصايا الدينية والمثال المسيحي عن تساوي البشر أمام الله ولولا هذه المصادر لما وجدت تلك الأفكار طريقها للمجتمعات الحديثة.
وأكد على أهمية التسامح بين الفهم الديني والفهم العلماني كما نقد بصورة واضحة استنساخ البشر مؤكداً على الهوية الإنسانية المهددة بالاستنساخ مما حدا بالكاردينال واستنغر (البابا فما بعد) لمحاورته في أبريل 2005م قبل أن يتبواْ موقع البابوية.
وعلى الرغم من أن "هابرماس" قد أشار إلى ظهور المجتمعات ما بعد العلمانية ونبه إلى ما قد تحملها من تراجعات وسلبيات التواكل والقدرية التي سوف تؤثر على النظام الديمقراطي، إلا أنه رفع من شأن الدين في تعزيز القيم وكبح روح التنافس والجشع وذلك نسبة لما يتميز به الدين من سمو وقدرة على مواجهة مسار النظام الرأسمالي.
ومما تقدم ذكره، تتضح أهمية تتبع هذه النظرات النقدية المتراكمة للتراث العلماني وتجربته في المجتمعات الغربية خاصة في مجال القيم والجوانب الروحية من أجل استعادة المعني ورفض منطق القوة وغلبتها في العلاقة بين الشعوب.
وبلا شك فإن اتساع نفوذ هذه التوجهات يأتي في صميم معرض الرد على سياسات الرأسمالية المتوحشة وثقافة الاستهلاك والمتع اللا محدودة والانحرافات التي تدب في نموذجها الحضاري، وقبل هذا وذاك فإن تلك العناصر تأتي دليلاً ناصعاً عن أن جسور التواصل والحوار بين الثقافات تمد مقترباتها رويداً رويدا..




 admin
admin